
هل كان التحوّل إلى العنف المآلَ الإجباري للثورة السورية؟
بقلم: أحمد مولود الطيار
جهة النشر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة Harmoon Center for Contemporary Studies
مقدمة
تدخل الثورة السورية عامَها الثاني عشر، وقد دفع الشعب السوري، منذ 15 آذار/ مارس 2011، أثمانًا باهظة في نضاله للانعتاق من نير حكم مستبد. وتقدّر المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أن 306,000 مدنيّ قُتلوا، منذ ذلك التاريخ حتى آذار 2021[1]. وأفادت المنظمة الدولية أن “أكثر من 14 مليون سوري أُجبروا على الفرار من منازلهم بحثًا عن الأمان، ولا يزال أكثر من 6.8 مليون سوري نازحين داخليًا في بلادهم؛ حيث يحتاج 70 بالمئة من السكان إلى المساعدة الإنسانية، ويعيش 90 بالمئة من السكان تحت خط الفقر”[2]. ومن جانب آخر، وصل تدمير البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة في جميع أنحاء البلاد إلى مستوى مروّع، إذ أدى قصف النظام المستمر إلى تدمير مدن بمعظمها وتسويتها بالأرض. وعلى الرغم من استعادة النظام سيطرته على معظم المدن السورية، بمساعدة روسيا وإيران، لا تزال هناك مناطق حسّاسة خارجة عن سيطرته في محافظة إدلب، حيث تسيطر قوات هيئة تحرير الشام، وفي مدن ومناطق شرق الفرات، حيث تسيطر قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.
في ظلّ الوضع الراهن للثورة، حيث الانسداد وغياب الحلول، لا يزال ناشطون ومفكرون وكتّاب سوريون يتوقون إلى بدايات الثورة السلمية، ويوجّهون نقدًا قاسيًا ومبالغًا فيه، مفاده أن انزلاق الثورة إلى العنف كان بسبب تخلّي الثوار عن النضال اللاعنفي وأدواته وتكتيكاته، وميلهم إلى العنف، وهو ما أدى إلى تلك النتائج الكارثية التي تعيشها سورية الآن[3]. ولا يرمي هذا البحث، كما قد يظن البعض، إلى تمجيد العنف وإيجاد المسوغات والمبررات له، ذلك العنف الذي انفلت وخرج عن النطاق وبات عبثيًا، إنما يبحث في أسباب هذا التحوّل، من ثورة سلمية وغير عنيفة، إلى نزاع مسلح مفتوح. ومن ثَم يحاول الإجابة عن سؤاله الرئيس: هل كان العنف هو الطريق الإجباري الذي أُرغمت الثورة السورية على المرور به؟
الإجابة عن هذا السؤال توجب علينا أولًا تحليل الكثير من الأوضاع السورية، وتحديدًا السياسات وديناميات الخلاف التي كان ينتهجها النظام السوري، تلك التي افترض البحث أنها الحتمية التي صاغها النظام من خلال سياسات غير منقطعة أدت، من خلال حوادثها و “منطقها”، إلى كل ما يحيق بسورية الآن من خراب. لذلك، يصل البحث إلى نتيجة تقول إن العنف الذي انتهت إليه الثورة ما هو إلا نتيجة حتمية فرضها النظام عبر حلّه الأمني العسكري العنيف. ويرى أن أي نقاش أو سجال حول استخدام العنف أو اللاعنف لإسقاط النظام، وتلك الأحكام الأخلاقية التي يسوقها الطرفان -أنصار اللاعنف وأنصار الحل العسكري- ضدّ بعضهما، هي على الأغلب نقاشات عبثية تجاهلت تلك الحتمية.
العنف المولّد
العنف المقصود به هنا هو محاولة الدولة وأجهزتها الأمنية والمخابراتية “استخدام القمع من أجل إنهاء المنافسين، عبر اعتقالهم ومضايقتهم وتدمير كل مقومات حياتهم، بالقتل والحصار والتجويع. والقمع هو واحد ضمن طيف متعدد من أنماط السيطرة الاجتماعية و”السياسية”، وهو يهدف على المدى القصير إلى شلّ حركة المعارضين، ويهدف على المدى الطويل إلى تثبيط أي عمل مستقبلي. وتراوح وسائل ذلك القمع وأدوات، بين الإعلام الذي يُوظَّف للاستهانة بالمعارضين وتشويه سمعتهم حتى شيطنتهم، عبر التلاعب بوسائل الإعلام، وإنشاء قوانين استثنائية، وإنشاء مستندات وبيانات مزورة للنيل من الخصوم والتحريض ضدهم، والمراقبة والحرمان من العمل، وصولًا إلى القمع المباشر من خلال الاعتقال والسجن والتصفيات الجسدية[4].
وبالنظر إلى كل ذلك الطيف المتعدد للقمع، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر؛ يجد أيُّ مراقب حيادي لسياقات الثورة السورية أنّ النظام السوري لم يترك وسيلة لقمع الثائرين إلا استخدمها، بل إنه “ابتدع” وسائل جديدة لم تخطر في بال أحد[5]. وكانت دورة العنف التي ابتدأها النظام تتفاوت في شدّتها، إذ كانت تأخد أشكالًا أعنف في مدينة سورية منها في أخرى؛ ففي مدينة داريا التابعة لمحافظة ريف دمشق؛ كان غياث مطر الملقب بــ “غاندي الصغير”[6]، وغيره كثير من النشطاء السلميين، يُقدّمون الماء والورود عند حواجز الجيش السوري، ليثبتوا للجيش أن المتظاهرين ليسوا معادين له[7]. وبينما كان النظام ينكّل ويسجن معظم نشطاء الثورة السلميين[8]، أصدر بشار الأسد، عام 2011 بعد بداية الثورة، مرسوم عفو خرج على إثره من سجن صيدنايا عددٌ من المعتقلين الإسلاميين، أبرزهم زهران علوش[9]. خروج أولئك المعتقلين، الذين شكّلوا لاحقًا أبرز الفصائل العسكرية لمواجهة الأسد، يرجعه محللون “إلى يقين النظام بأنهم سيجدون طريقهم إلى قيادة الحراك الشعبي بخلفيات متشددة، ما سيسهّل عليه محاربتهم بذريعة الإرهاب والتطرف”[10].
بنية النظام السوري وحتمية العنف
على عكس ما تقول به شعارات النظام وكذلك الدستور السوري، من أن “سورية دولة ديمقراطية ورئيسها منتخب وتحكمها سيادة القانون ودستور يحدّد حقوق وواجبات المواطنين والمسؤولين، من ضمنها حقوق الإنسان”، نجد أن سورية في الواقع دولةٌ بوليسيةٌ، يسيطر فيها الرئيس وعائلته على السلطة من خلال أجهزة أمن ومخابرات، مهمتهما الرئيسة قمع المعارضين واجتثاثهم، حتى إن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة والتعذيب وحالات الاختفاء هي أمورٌ روتينية تمارسها قوات الأمن، مع الإفلات من العقاب”[11]. هذا التوصيف المكثف لطبيعة ذلك النظام الذي بناه حافظ الأسد، منذ تسلّمه للسلطة عام 1970 من القرن الماضي، طبع كل الجو السياسي وديناميات الخلاف في سورية على مدى تلك العقود السابقة، حتى تفجر الربيع العربي.
يصنفTilly و Tarrow، في كتابهما “السياسة الخلافية”، الأنظمةَ التي ثارت عليها شعوبها، ومنها الأنظمة العربية التي انفجرت في وجهها ثورات الربيع العربي؛ أنظمةً “غير ديمقراطية، ذات قدرة منخفضة”، وكلّها أنظمة عسكرية شكّلت جوهر ما يسمى الدولة المركزية، ولم تحكم بشكل ثابت وفعال على أراضيها الوطنية[12]. ويضاف إلى ذلك أن إدارة الخلاف السياسي في تلك الأنظمة، وتحديدًا النظام السوري، لا تشبه حتى أنظمة دكتاتورية في أمريكا الوسطى، كنيكاراغوا والسلفادور، ولا حتى النظام القمعي في إيطاليا، وكيفية تعامله مع الاحتجاجات التي ثارت ضده، في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، فيما عرف وقتها بـ “سنوات الرصاص”؛ ذلك بأن القمع الإيطالي كان “انتقائيًا، وتوجّه إلى الراديكاليين لعزلهم”[13]. أما في حالة بعض دول أمريكا الوسطى، وإن أدى القمع السلفادوري، على سبيل المثال، إلى حرب أهلية، فإنه لم يرتقِ في الشدة إلى القمع الذي مارسه نظام بشار الأسد ضدّ المحتجين الذين ثاروا ضده، إذ إنّ بشار الأسد ألقى اللوم على المتظاهرين، في شباط/ فبراير 2012، واتهمهم بأنهم عملاء للخارج، وفي الشهر السابع، ارتكب جيشه مجزرة دموية في قرية التريمسة، مفتتحًا حربَه الأهلية[14]. و “لم تكن سورية، في بداية الثورة، دكتاتورية وطنية، مثل إسبانيا تحت سلطة فرانكو حتى منتصف سبعينيات القرن الماضي، أو مثل كوريا الجنوبية قبل نهاية الدكتاتورية بعد إسبانيا بنحو عقد”[15]. بل إن النظام السوري لا يشبه في دمويته حتى أقرانه العرب من دول الربيع العربي، ففي مصر شهدت ساحة التحرير مظاهر أسطورية من التنسيق والتفاعل بين مختلف المصريين، وكانت أشبه ببرلمان واسع لكل أطياف الشعب المصري، وفي تلك الأثناء، “كان السوريون في المدن السورية عالقين تحت الدمار والحصار الرهيب، بين بشار الأسد وأطراف المعارضة الراديكالية الإسلامية فيما بعد”[16]. ذلك الاستقطاب الرهيب بين الطرفين -النظام السوري من جهة وداعش وجبهة النصرة من جهة أخرى- الذي دفعت إليه سياسة الإبادة التي اتبعها النظام منذ اندلاع الثورة؛ طبعت كلّ المشهد السوري حتى اللحظة. وهناك من يذهب إلى أبعد من ذلك، في تصنيفه للنظام السوري، ويرى أنه نظام شبيه بالمافيا الإيطالية، حسب الوصف الوارد في مقال في مجلة الإيكونيميست البريطانية، ” Son of a gun”؛ فـ “إذا كان حافظ الأسد يشبه دون كورليوني، في فيلم العرّاب، فإن وريثه بشار يمكن أن يكون ابن الدون”[17]. لكن هذا التشبيه أيضًا يبدو عاجزًا عن الإحاطة ببنية ذلك النظام، فمقال الإيكونيميست يفترض أن “ابن الدون”، أو بشار الأسد، هو رجل إصلاحي، غير أن الواقع مخالفٌ لذلك، فقد أثبتت الثورة والمآل الذي وصلت إليه سورية أن الابن قد فاق أبيه قتلًا ووحشية، حيث سوّى مدنًا سوريةً بأكملها بالأرض، ولذا تكاد العلوم السياسية تقف عاجزة عن أن تجد تصنيفًا مقنعًا ودقيقًا يوصّف النظام السوري. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن التعبير الأدق، حسب ياسين الحاج صالح، هو أن سورية “في الحقبة الأسدية، دولة طغيان سلطاني وراثي، ذي منازع إبادية، وليست بحال نظامًا دكتاتوريًا”[18].
هندسة اجتماعية
هذه البنية المغلقة والطاردة للسياسة ليست وليدة اليوم، إنها “هندسة اجتماعية” اشتغل عليها جيدًا الرئيس السوري السابق حافظ الأسد 1970-2000))، حيث وجّه جلّ تركيزه إلى ضمان ولاء الجيش والأجهزة الأمنية، وتحديدًا “داخل سلك الضباط، لضمان وضع الضباط العلويين المرتبطين به أو المدينين له في قيادة أكثر الوحدات إستراتيجية، وتحديدًا في المدن الكبرى، حلب ودمشق”[19]. هذه “الهندسة” قد تفسر أن الانشقاقات اللاحقة التي حدثت أثناء الثورة داخل الجيش لم تكن مؤثّرة؛ حيث لم يتوافر حلفاء مؤثرون أو مؤيدون للثورة داخل النظام، يكونون قادرين على إحداث تغيير حقيقي. أما أولئك الذين سعوا إلى التخلي عن هذا الولاء، فقد كانوا غير مؤثرين، سواء على المستوى العسكري أو المدني. في 29 تموز/ يوليو 2011، أعلن العقيد رياض الأسعد -في مقطع فيديو على موقع يوتيوب- انشقاقه مع ضباط آخرين، وتشكيل الجيش السوري الحر، ودعا الأسعد عناصر القوات الحكومية إلى “ترك وحداتهم العسكرية، والانضمام إليه لتشكيل جيش وطني قادر على حماية الثورة وكل قطاعات الشعب السوري بمختلف طوائفه”[20] . لكن تجربة الأسعد وصغار الضباط فشلت، بسبب ضعف نفوذهم. والأمر نفسه يمكن أن يقال في انشقاق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب، وإن كان أحدث زوبعة صغيرة وأضرت بسمعة النظام، إلا أنها زوبعة في فنجان، سرعان ما تلاشت كلّ آثارها، حيث لم يكن “مجلس الوزراء ومجلس الشعب والسلطة القضائية ووسائل الإعلام سوى أدوات رئيسة للنظام”[21]، يتلاعب بها خدمة لأغراضه السلطوية. تلك البنية التي لا تعترف بالسياسة كصراع سلمي، وأنها الحقل المناسب لتفريغ واحتواء الصراعات وتقديم التنازلات من أجل المصلحة العليا، كان لها انعكاسات مدمّرة، لأنها لا تعترف بالآخر، وهذا ما ثبت بعد اندلاع الثورة، حيث العنف يولّد العنف، وهو ما يشير إليه Tilly وTarrow، فأنواع التكتيكات أو “الذخيرة” التي يستخدمها الناشطون والمحتجون، في مواجهة النظام الذي يحكمهم، محكومة بنوعية النظام الذي يواجهون، وهي تعتمد على الفرص والهياكل السياسية المتاحة للمحتجين[22]. وبما أن النظام السوري هو نظام غير ديمقراطي ذو قبضة حديدية تجاه أي صوت ناقد، ولا يترك أي منفذ أو مخرج ديمقراطي لحل أي إشكال، ويمتلك قدرة منخفضة على مستوى تقديم الخدمات والرفاهية لشعبه؛ فإن “ديناميات الخلاف”، مع معارضيه ومع شعبه، تتخذ أشكالًا راديكالية، وهذا الامر قاد ويقود -قبل الثورة وبعدها- إلى استقطابات خطيرة، أدت إلى ما تشهده سورية اليوم من صراع أهلي مدمر. ومع ضعف سيطرة النظام المركزية على حدوده الجغرافية، بات ذلك الصراع الأهلي مفتوحًا على الخارج، ومدعومًا من أطراف إقليمية ودولية تتحرك وفقًا لأجنداتها ومصالحها الخاصة. فعلى عكس مصر وتونس، أُعيد تشكيل ديناميات الخلاف في سورية، من خلال العنف الذي استخدمه النظام مند البداية، لسحق الثورة وسحق الاحتجاجات بكل الوسائل، وخاصة الطائفية التي أدت الى عسكرة الانتفاضة، واتجهت نحو حرب أهلية واسعة النطاق[23] .
وفي معرض تحليل طبيعة النظام السوري، من المهم جدًا الإضاءة قليلًا على العلاقات داخل ذلك النظام، وكيفية إدارة الخلاف السياسي بين أركانه؛ فمع تبيّن صعوبة حدوث اختراق مهم داخل قوقعة ذلك النظام، تجعل الكفة تميل لصالح الثوار؛ خيّم اليأس على أجواء الثورة. هذا الانسداد، مع ازدياد القمع على كل الصعد والمستويات من قبل أجهزة الأمن والمخابرات والشّبّيحة، حتمًا سيقود إلى ردّة فعل عنيفة، تساوي العنف المولّد، قد تقلّ عنه أو قد تتجاوزه، وهذا ما أثبتته وقائع وأحداث الثورة السورية. فالنظام ليس مغلقًا تجاه الدوائر البعيدة والأبعد فحسب، بل هو مغلق ضمن محيطه وبطانته الداخلية، حيث مركزية القرار ضمن دائرة ضيقة جدًا، تضمّ الرئيس ومن حوله ثلاثة أو أربعة أشخاص يثق بهم. ويمكن في هذا المجال سرد كثير من القصص، حول الشك وعدم الثقة التي يتوجس منهما الدكتاتور. وهناك أيضًا مسألة مهمة، هي كيفية عمل ديناميات الخلاف السياسي: انقلاب حافظ الأسد على معلّمه وأستاذه صلاح جديد عام 1970، الانقلاب الذي بات اسمه “الحركة التصحيحية”، وهو انقلاب حدث داخل حزب البعث، واستخدم المتصارعون فيه كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة في التشهير ببعضهم، من تخوين وانحراف وعمالة للخارج، وما شابه ذلك من مصطلحات ومفاهيم امتلأت بها أدبيات حزب البعث، في محاولة لإقصاء الآخر وشيطنته. وهناك أيضًا الخلاف الشهير بين حافظ الأسد وأخيه رفعت، الذي كاد أن يتطور إلى صراع عسكري في ثمانينيات القرن الماضي، ثم انتهى بتسوية قضت بإبعاد رفعت عن سورية، بعد حصوله على جلّ أموال البنك المركزي السوري، وفقًا لمصطفى طلاس في كتابه “ثلاثة أشهر هزت سورية”[24]. وأخيرًا، وليس آخرًا، هناك الانفجار الذي أودى بما يسمّى “خلية الأزمة” عام 2012، وقُتل فيه سبعة أشخاص من أهمّ أعمدة النظام الأمنية والعسكرية، بينهم رجل الأمن القوي آصف شوكت (زوج شقيقة بشار الأسد). كل تلك الصراعات وغيرها هي صراعات على السلطة ومراكز النفوذ، وهي أمثلة دالّة تعطي فكرة واضحة عن كيفية اشتغال ديناميات الخلاف السياسي في ظلّ الحكم البعثي: انقلاب عسكري في حالة حافظ الأسد ضد صلاح جديد عام 1970؛ تسوية على حساب الشعب السوري وقوته اليومي، بين حافظ الاسد وأخيه رفعت؛ اغتيالات وتصفيات جسدية في حالة “خلية الأزمة”، ومع أن الفاعل لا يزال مجهولًا، فإن أصابع الاتهام تُوجّه إلى بشار الأسد وفريقه. وأيًّا يكن الفاعل، فهذا يعطي فكرة واضحة عن انغلاق الأفق السياسي في ظل النظام البعثي وعن حالة شلل تام لأي ديناميات تفاعلية. أما على مستوى الدائرة الأبعد، فعلى الرغم من ادّعاء النظام بأنه يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة؛ فإن نواته الصلبة تأتي من الطائفة العلوية. وعلى عكس كلّ الرؤساء السابقين الذين حكموا سورية، فإن حافظ الأسد، منذ انقلابه عام 1970، جعل “كلّ أجهزة الدولة تحت سيطرته وسيطرة عائلته الشخصية، وقام بتوسيع الجيش والأجهزة الأمنية المرهوبة الجانب إلى حد كبير؛ وحتى حزب البعث أصبح أكثر من مجرد أداة للرئيس، مسقطًا جميع الالتزامات الأيديولوجية السابقة، ما عدا الالتزام الخطابي”[25]. وفي عهد بشار الأسد، استمر الحال ولم يختلف كثيرًا؛ فدستور عام 2012 الذي يُعدّ جزءًا من ردات فعل النظام السوري تجاه ثورة تطالب بالديمقراطية بدأت عام 2011، يسعى ظاهريًا إلى إدخال الديمقراطية والتعددية وإنهاء السيطرة الاحتكارية لحزب البعث وعائلة الأسد على السلطة، ويحدد ولاية الرئيس بفترتين رئاسيتين كل منهما سبع سنوات، إلا أن ذلك جاء ليؤكد من جديد كيفية اشتغال السياسة كديناميات تفاعلية ظلت مشلولة كما كانت، رغم محاولات النظام تجميلها. فالرئيس حسب ذلك الدستور “يضع السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها”، ويكاد يحتفظ بصلاحيات مطلقة. وبغض النظر عن الدساتير السورية: هل تفي بالغرض أم لا، فإن جوهر المشكلة السورية أبعد من ذلك بكثير، فدستور عام 1973 الذي يتضمّن أحكامًا رنانة، حول التعددية والديمقراطية والحرية، لم يوفر الحماية للسوريين من عنف أجهزة مخابرات حافظ الأسد، وكذلك دستور عام 2012 لم يمنع بشار الأسد وأجهزته الأمنية من “قتل وسجن وتعذيب الناشطين المدنيين المطالبين بالديمقراطية وعائلاتهم، وتدمير ونهب منازلهم، مع الإفلات من العقاب، ويستمر في هذه الأعمال حتى بعد اعتماد الدستور”[26].
لا مجال للسياسة!
“الأسد أو نحرق البلد”. يلخّص هذا الشعار الذي رفعه النظام وموالوه، مع تفجر الثورة، وقد طبّق حرفيًا، الجانب الأهم في كيفية إدارة النظام لديناميات الاختلاف السياسي، وتحديدًا كيفية تعامله مع ثورة انطلقت بأفعال وشعارات سلمية، كذلك يعطي فكرة شاملة عن أسباب وصول العنف إلى ما وصل إليه خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية. وفي مقابلة مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، أجرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية (2011)؛ رأى الأسد أن سورية منيعة تمامًا، وبعيدة عما تعاني منه دول أخرى في المنطقة، مثل تونس ومصر، وأرجع ذلك إلى العلاقة الوثيقة بين الحكومة ومصالح الشعب السوري[27]. وتزعم معظم الأنظمة العربية أنها بعيدة كل البعد عن إمكانية اندلاع مثل هذه التظاهرات، بسبب اختلاف الأوضاع، أو ما يسمى بـ “الخصوصية”، والواقع يقول إن هذه الأنظمة متشابهة جدًا، ولديها قواسم مشتركة كثيرة، وأكثر ما يجمعها هذا الثالوث المألوف الذي بات بدهيًا: تحالف آلة الدولة والحزب الحاكم والجهاز العسكري/القمعي[28]. وإذا كان هناك من خصوصية في الوضع السوري، وهي موجودة، فهي خصوصية من نوع آخر يحاول النظام طمسها عبر شعارات شعبوية وديماغوجية. تلك الخصوصية تتمثل في “هيمنة العلويين على الجيش، وعلى معظم مقدرات سورية”[29]. قبل عام 2011، استنزف هذا الثالوث الحاكم كل مقدرات الدولة، وهنا يمكن فهم تشبيه مقال الإيكونيميست، الذي أشرنا إليه سابقًا، وأن النظام السوري أشبه بالنظام المافيوي الذي نهب سورية تمامًا، وحوّلها إلى مزرعة لعائلة آل الأسد يتصرف فيها كما يشاء. أما “بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، فقد لعب ذلك الثالوث دورًا آخر، حيث أعاق الانتقال الديمقراطي”[30].
وهكذا، ضمن تلك الخصوصية، لم تكن سورية بمنأى عن تمدد الربيع العربي الذي بدأ في تونس، ووصل إلى مصر واليمن والبحرين، ثم في ليبيا. وإن تأخُّر هذا الربيع في الوصول إلى سورية يفسّره أن قوات الأمن السورية هي الأكثر قمعًا، مقارنة بمصر وتونس؛ فالجيش “والمؤسسات الأمنية” في سورية يسيطران على كل شيء، ولهما القول الفصل[31]. ومع ذلك، لعب هذا العامل عكس ما كان متوقعًا منه، حيث أسهم ازدياد الوحشية والقمع في إثارة الاضطرابات وفي ازدياد حدة التظاهرات. واستنادًا إلى ما سبق، بالضدّ من تصريحات رئيس النظام السوري التي أشرنا اليها، فإن الحالة السورية تتجمع فيها كل عوامل التفجّر والعنف التي يتّحد فيها الفشل السياسي والكارثة الاقتصادية. وفي تشريح عِلم وأسباب الثورات التي حدثت قديمًا وحديثًا؛ تتجمع في الثورة السورية كل العوامل والأسباب: عوامل اجتماعية، مثل المحسوبية والفساد؛ عوامل اقتصادية، مثل ارتفاع معدلات البطالة والنزوح الكثيف من الريف إلى المدن؛ العوامل السياسية، كغياب الحريات والإعلام[32].
الشكل العام للاحتجاجات
لفهم كيفية انزلاق الثورة نحو العنف وأسبابه، من المهم جدًا الإشارة إلى أن الثورة السورية انتفاضة شعبية غير منظمة، تفتقر إلى تخطيط مسبق من قيادة وطنية، ولا تتبنى أي أيديولوجية محددة، ولا تتلقّى أي أوامر خاصة. إنها تشبه الثورة التونسية أكثر من الثورة المصرية[33]؛ ففي مصر، لعبت حركات الشباب دورًا محفزًا في تنظيم التظاهرات، مثل حركة 6 أبريل، وكان لمقتل خالد سعيد على يد أجهزة الأمن دور محوري في تحديد بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس مبارك، التي انطلقت في 25 يناير عيد الشرطة. أما في سورية، فكان من المستحيل أن تكون التظاهرات منظمة أو شبه منظمة، من قبل أي حركة في سورية، نظرًا إلى القبضة الأمنية القوية. ولو افترضنا جدلًا وجود عملية التنظيم، فإنها كانت سرّية[34]. لذلك، كانت “الذخيرة” أو التكتيكات التي استخدمها المتظاهرون، في أماكن مختلفة في كل مدينة سورية، عشوائية في الغالب، وتقريبًا كانت دون أي تحضير مسبق. الاستثناء الوحيد كان صفحةً على (فيسبوك)، “الثورة السورية ضد بشار الأسد”، يديرها معارضون في المنفى، وكثيرًا ما دعت هذه الصفحة السوريين للتظاهر، لكن القائمين عليها فشلوا. فيما بعد تشكّلت نويّات لبعض التنسيقيات، لعبت بعض الأدوار المهمة، لكنها اقتصرت على مراكز مدن قليلة. ولا شك أن المسجد لعب دورًا محوريًا في حشد هذه التظاهرات السلمية، خاصة في المدن الكبرى، حيث استخدمت المساجد كنقطة انطلاق للاحتجاجات وليس كدور إرشادي، كما يروّج أدونيس مثلًا. لكن هذه العشوائية تُعدّ نتيجة طبيعية، في ظل قانون الطوارئ المعمول به في سورية منذ أكثر من 50 عامًا، الذي يحظر التظاهرات والتجمعات، وقد نجح في تدمير التقاليد الطبيعية لتدريب الشباب على الخروج والتحدّث والتمثيل والاحتجاج والمطالبة بحقوقهم[35]. والقول إن الجوامع لعبت دورًا إرشاديًا يتجاهل التدمير الممنهج الذي قام به النظام السوري في قتل كل مظاهر السياسة في سورية. ولم يكن القادة، في غالبيتهم، الذين لعبوا دور المحرك في التظاهرات ينتمون إلى أي أيديولوجية أو حزب سياسي تقليدي. وقد تجنبوا الانتماء إلى أي حزب سياسي أو الاتصال بالقادة السياسيين الذين تعارضت أيديولوجياتهم مع الدوافع الأصلية لتحركاتهم[36]. هذه الظاهرة العالمية، عدم الثقة في الأحزاب أو “مناهضة الحزب”، هي ما يصفه سيمون تورمي -في كتابه “نهاية السياسة التمثيلية”- بأنه “خطأ في السياسة”، أو بتعبير آخر هي “عدم الثقة بالسياسيين والطبقة السياسية”[37] . وسورية ليست استثناء، بل إن سورية ليس لديها “خطأ في السياسة”، لأنه -ببساطة- لا توجد سياسة إطلاقًا، وهذا يحتاج إلى أكثر مما قاله تورمي.
العنف طريق إجباري
في الختام، بالرغم من إغفالنا لكثير من السياسات التي طبّقها النظام السوري وقادت إلى “توحّش الثورة”؛ نتساءل، حسمًا لذاك السجال الذي يثيره كثيرون حول مسألة العسكرة أو اللاعنف الذي كان يجب أن تسلكه الثورة السورية: ترى هل من المنطقي التوقّع، في ظلّ وحشية النظام السوري التي أشرنا إلى بعض جوانبها في هذا المقال وكيفية إدارته للخلاف السياسي، أن تظلّ الثورة السورية محافظة على لونها الورديّ إلى آخر الشوط؟! يبدو أن هناك كثيرين لديهم تلك الرغبويات، وهو وعي غير مطابق، إن جاز لنا قول ذلك، قادمٌ من هوامش بعض الكتب تلك التي تتحدث عن تكتيكات وسياسة اللاعنف، متناسين أن تلك التكتيكات والوسائل إنما تصلح في الأنظمة الديمقراطية أو النصف ديمقراطية، وحتى في بعض حالات الاحتلال، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال إسقاط أنظمة شمولية، كالنظام السوري، ولا يمكنها أيضًا -بأي حال من الأحوال- أن تُحدث أيّ تغيير في طبيعة وبنية ذلك النظام، والقول بعكس ذلك هو نقاش عبثي لا طائل منه، وغير مدرك لتلك الحتمية التي رسمها نظامٌ بنى كل ركائزه وسياساته على العنف. تقول حنا آرندت، في كتابها المعنون (في العنف): “لو أن إستراتيجية غاندي الناجحة والقوية، التي قامت على مبدأ المقاومة اللاعنفية، وجدت نفسَها مضطرة إلى مواجهة عدوّ آخر -روسيا ستالين مثلًا، أو ألمانيا الهتلرية، أو يابان ما قبل الحرب- غير إنكلترا، فمن المؤكّد أن النتيجة لن تكون رحيلَ الاستعمار عن الهند، بل ستكون مجزرة وخضوعًا عامّين”[38]. آرندت -بالتأكيد- ليست في معرض مديح الاستعمارين الإنكليزي والفرنسي، إنّما ترى أن فرنسا وإنكلترا “كان لديهما أسباب وجيهة تدفعهما إلى عدم الذهاب أبعد مما ذهبتا إليه؛ فالحكم عن طريق العنف وحده لا يعني شيئًا آخر غير العبث، بعد أن تكون السلطة قد فُقدت”[39]. هل نحن هنا بحاجة إلى التذكير أن حافظ الأسد ووريثه سليلا المدرسة الستالينية في العنف؟ وهل نحتاج أيضًا إلى التذكير بأن الشعب السوري يعيش منذ عام 2011 حالة هولوكوست آخر، وإن اختلفت وسائل القتل والتدمير؟ وأخيرًا، وفقًا لتحليلات آرندت التي نسقطها على الوضع السوري؛ لم يفقد بشار الأسد السلطة من جرّاء عنفه المدمّر فقط، بل إن “سورية ذاتها باتت في أزمة وجودية قد لا تنجو منها”[40].


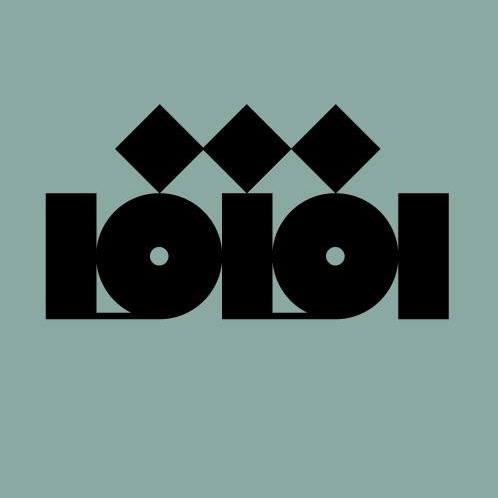




Add Comment