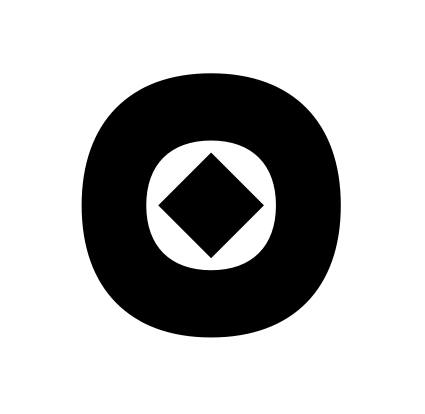سياسة النوع والمرونة السلطوية: نظام الكوتا النسائية بالمغرب كآلية لدعم النظام
إعداد: محمد ضريف
جهة النشر: Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
تحاول هذه الورقة الإجابة عن الإشكالية الآتية: كيف أدى التهجين الذي تعرض له النظام السياسي المغربي إلى الانفتاح السياسي، وإطلاقه لإصلاحات ليبرالية من خلال توسيع فرص التمكين السياسي أمام النساء في المؤسسات المنتخبة دون تعريض نظامه لعدم اليقين الديمقراطي الحقيقي؟ تستند هذه الإشكالية على فرضية مفادها أن النظام السياسي المغربي من بين الأنظمة السياسية الهجينة التي عملت منذ انتخابات سنة 2002، مرورًا بالإصلاحات الدستورية والقانونية لسنة 2011، على بلورة سياسات لتمكين المرأة في المؤسسات المنتخبة عن طريق نظام «الكوتا»؛ لدعم النظام السياسي في الأساس وليس لترسيخ الديمقراطية؛ إذ أوضحت نتائج هذه الدراسة أن الزيادة العددية للنساء المنتخبات في مجلس النواب عن طريق اللائحة الوطنية، لم يقد لتمكين سياسي حقيقي، بقدر ما قاد لإدخال سقف زجاجي جديد، يعيق إلى حد كبير الترشح والفوز خارج اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، فضلًا عن تحويل نظام «الكوتا» في الكثير من الدورات الانتخابية من كونه آلية للتمكين السياسي والنهوض بالتمثيلية النسائية، إلى آلية لإعادة الإنتاج الاجتماعي وأداة لخدمة وتعزيز سياسات المحسوبية والريع الحزبي.
مقدمة
لطالما اهتم علماء السياسة بالكيفية التي يتم بها تشكيل المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية، مثل الأنظمة الانتخابية، الأجندات التشريعية والأدوار التمثيلية لأعضاء البرلمان. لكن، مع الإصلاحات الانتخابية الكبرى التي برزت في العقود الأخيرة، والتي أثرت بعمق في جوهر الديمقراطية التمثيلية، تم إدخال مسألة النوع الاجتماعي في الانتخابات من خلال ما يعرف بنظام الحصص أو «الكوتا»؛ إذ تبنت أكثر من مئة دولة ديمقراطية، وغير ديمقراطية، حصصًا طوعية وإلزامية للجنسين من أجل معالجة التمثيل الناقص للمرأة داخل الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية.[1]
ومع نهاية ثمانينيات القرن العشرين، أصبح مستقبل الأنظمة العربية مرتبطًا بمدى انفتاحها السياسي، في ظل نظام عالمي جديد، رسمت معالمه سردية «النهايات»، التي أطلقها المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما في أطروحته الموسومة بـ«نهاية التاريخ»؛[2] إذ دفع انتصار الخيار الليبرالي، بلغة هذا المفكر، العديد من السلطويات العربية لتبني القضايا الحقوقية، والالتزام بالمواثيق الدولية، ومن بينها قضايا النساء. وبطبيعة الحال، لم يكن النظام السياسي المغربي بمنأى عن هذه التحديات الجديدة، إذ وجد نفسه مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي أمام نوع جديد من المطالب، دفعته للاعتراف بقضايا النساء.
تبلورت مسألة تمكين المرأة في المؤسسات السياسية بالمغرب، في سياق الانفتاح السياسي الذي قاد لتبني رزمة من الخيارات السياسية الهادفة لتوسيع المشاركة المجتمعية في ظل أفكار الليبرالية السياسية؛ وكانت هذه الإصلاحات مؤشرًا على انفتاح النظام السلطوي، من خلال توسيع هامش حرية التعبير والتنظيم الحزبي وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية، وهو ما أُطلق عليه «السلطوية الملبرلة».[3] رغم ذلك، لم تستطع هذه الإصلاحات تفكيك البنية السلطوية للنظام، المهيمن على القرارات الاستراتيجية، في ظل انتخابات لا تهدد استمراريته.[4]
تحاول هذه الدراسة، الإجابة عن الإشكالية الآتية: كيف أدى التهجين الذي تعرض له النظام السياسي المغربي للانفتاح السياسي وإطلاقه لإصلاحات ليبرالية من خلال توسيع فرص التمكين السياسي أمام النساء في المؤسسات المنتخبة دون تعريض نظامه لعدم اليقين الديمقراطي الحقيقي؟ وتستند هذه الإشكالية على فرضية مفادها أن المغرب، رغم انخراطه في بلورة سياسات صديقة للمرأة من خلال التمكين السياسي لها في المؤسسات المنتخبة عن طريق نظام «الكوتا» منذ انتخابات سنة 2002، مرورًا بالإصلاحات الدستورية والقانونية التي تمخضت عن الحراك الاجتماعي لسنة 2011؛ إلا أن طبيعة الحقل السياسي والحزبي حالت دون تعزيز مسارات التمكين بشكل فعلي، حتى أضحى التمكين السياسي إصلاحًا سطحيًا بدون رؤية استراتيجية، ولبرلة بلا أفق ديمقراطي.
ورغم الكم المتزايد من الأبحاث التي عالجت موضوع «المشاركة النسائية في المغرب»، يُلاحَظ أن غالبيتها تجاهلت معالجة هذه الإشكالية في إطار السياق المؤسسي السلطوي، بقدر ما غيَّبت إشكالية طبيعة النظام السياسي غير الديمقراطي؛ الأمر الذي أفقد هذه الكتابات طابعها النقدي. لذا، تقتضي أي دراسة موضوعية للمشاركة النسائية في المؤسسات السياسية، فهم الخصائص المؤسسية التي تدعي احتضانها للتمكين السياسي؛ إذ يصعب إدراك مسألة التمكين السياسي للمرأة في المؤسسات السياسية بمعزل عن طبيعة هذه المؤسسات نفسها.
وفي سبيل تفكيك إشكالية هذه الورقة البحثية، تم توظيف إطار نظري، ينهل من الأدبيات الناشئة عن نسوية الدولة في الأنظمة غير الديمقراطية؛ لربط القضايا المحلية بالنقاشات النظرية على المستوى الكوني. كما تم اعتماد مقاربة منهجية تستند إلى المنهج الوصفي التحليلي؛ لوصف السياقات المتحكمة في إعمال سياسة التمكين السياسي عبر آلية نظام «الكوتا» في التجربة السياسية المغربية، وتحليل مدى انعكاس الإصلاحات الدستورية والقانونية التي تمت بلورتها خلال الفترة الممتدة بين سنة 2002 و2011 على واقع التمكين السياسي للنساء المغربيات، عبر خطة بحثية جمعت بين الاطلاع على الدراسات العربية والأجنبية التي اشتغلت على موضوع «الكوتا» النسائية في المغرب وفي التجارب المقارنة، والانفتاح على تصورات ومواقف النساء السياسيات والحقوقيات من تجربة نظام «الكوتا» من خلال الحوارات والمجموعات البؤرية التي قامت بها.
الإطار النظري
منذ نهاية الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، تزايد تركيز العديد من الدراسات المقارنة على العوامل التي تكبح مسارات التحول الديمقراطي، وتعزز مرونة الأنظمة السلطوية. وركزت هذه الأبحاث الحديثة على مسألة أداء النظام السلطوي في مجال التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات الاجتماعية، ومدى انعكاسها على تعزيز أو إضعاف استمرارية السلطوية. في المقابل، لم تجذب سياسات الأنظمة السلطوية، الموجهة لتمكين وتعزيز وضعية المرأة داخل مؤسساتها السياسية من أجل الحفاظ على حكمها، انتباه الباحثين بالشكل الكافي.[5]
غالبًا ما تلجأ الأنظمة السلطوية إلى مزيج من الاستراتيجيات، التي من شأنها أن تُرسخ حكمها؛ فإلى جانب قمع القوى المناوئة لها، تميل هذه الأنظمة إلى الاستقطاب والانفتاح على أكبر عدد من الفاعلين الاستراتيجيين من خلال عملية الإدماج السياسي الانتقائي، وذلك لجعل حكمها غير الديمقراطي أكثر مرونة. وهو ما دفع الكثير من الأنظمة السلطوية لإدراج قضايا النوع الاجتماعي ضمن أجندتها السياسية، وربطها باستراتيجيات الشرعية أو الاستقطاب، أو سياسة «فرِق تسُد» لتعزيز بنيتها المؤسسية السلطوية.[6]
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، ساهم حرص الأمم المتحدة على تعزيز حقوق المرأة على الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي في الدول الديمقراطية الغربية أولًا، ثم انتقل النقاش حول «نسوية الدولة» إلى خارج العالم «الغربي» وتم تطبيقه على «ما بعد» الأنظمة السياسية الاشتراكية والدول السلطوية في البلدان النامية أيضًا مع انهيار جدار برلين؛ إذ وضعت الأنظمة السلطوية سياسات وقوانين تهدف من خلالها لتعزيز المساواة بين الجنسين مثل نظام الحصص «الكوتا». إلا أن الدافع الرئيس وراء مثل هذه التدابير في كثير من الأحيان لم يكن النهوض بحقوق المرأة في حد ذاتها، بقدر ما هدف بالأساس للحفاظ على السلطة.[7]
الانفتاح السياسي الذي عرفته الأنظمة السلطوية مع نهاية عقد الثمانينيات، دفعها لإدخال بعض الإصلاحات السياسية الليبرالية، مع تزايد اهتمامها بتحسين وضعية المرأة دون تخفيف قبضتها الحديدية على السلطة؛ إذ سعت هذه الأنظمة لإدخال نظام «الكوتا» وتعزيز الحقوق السياسية للمرأة ظاهريًا مع تقويضها على مستوى الممارسة.
وجود النساء داخل هذه المؤسسات لا يعني بالضرورة أن هذه الأنظمة تتجه لترسيخ الديمقراطية والمساواة السياسية، ما لم يقترن ذلك بتحول جذري في بنية النظام السلطوي؛ على سبيل المثال تمتلك «رواندا» النسبة الأكبر عالميًا من النساء في البرلمان، بنسبة 61.3%، ولكنها رغم ذلك دولة سلطوية تعرض المناضلات والناقدات النسويات للقمع.[8]
بمعنى أخر، أصبحت الأنظمة السلطوية تدفع بفكرة تمكين النساء بمقاعد برلمانية عن طريق «الكوتا»، وتعمل على خلق خطاب جذاب حول حقوق المرأة داخل المحافل الدولية؛ كمحاولة لتسويق صورة مزيفة لأنظمتها المتصلبة، بينما تعمل بشكل مستمر وممنهج على انتهاك حقوق الإنسان الأخرى.[9]
وتسعى السلطوية من خلال ممارستها «الكرنفالية» هذه للحصول على الدعم السياسي، وتحصين أنظمتها وإعطاء انطباع على أن هناك تغيير يحدث داخلها؛ لأنها تعتقد أن تعزيز حقوق المرأة سيكون أقل تكلفة، من الناحية السياسية، من توفير «حاجيات التنسيق»، التي تتمثل في الحريات المدنية وحرية التعبير والانتخابات الحرة والعادلة التي تحمل الكثير من عدم اليقين الديمقراطي، فضلًا عن كونها تُشكل تهديدًا لأنظمتها السلطوية الهشة.[10]
بناءً على ذلك، تسعى العديد من «السلطويات الملبرلة» لإضفاء الشرعية على نفسها من خلال تصوير الإعمال الجزئي لحقوق المرأة كخطوة مهمة نحو الديمقراطية، وتشكل هذه الاستراتيجية جزءً من محاولات أوسع من جانب هذه الأنظمة لتصوير نفسها باعتبارها متوافقة مع المعايير الدولية للديمقراطية والحوكمة؛ إذ كثيرًا ما يتم استغلال حقوق المرأة في هذه الأنظمة لتحقيق أهداف سياسية، ولإظهار أن التحول الديمقراطي تم إطلاقه بجدية.[11] كما أن هناك من الأنظمة السلطوية من تستخدم المسألة النسوية كاستراتيجية للوصول إلى المساعدات الدولية، من خلال إدماج الناشطات النسويات داخل الشبكات الزبائنية.[12]
الانفتاح السياسي وبروز النظام الهجين
لم تخضع تجربة الإصلاح السياسي والدستوري التي عرفها المغرب مع مطلع التسعينيات للخطوات المألوفة في الانتقال الديمقراطي من اللبرلة[13] (التحرير) والاختراق والترسيخ،[14] بقدر ما قادت لبروز نظام سياسي تعصى مؤسساته وقواعده ومنطقه أن تُدرج ضمن النموذج الخطي العام للدمقرطة؛[15] فعدم تطعيم هذا المسار الإصلاحي بمؤسسات وممارسات ديمقراطية تنعش الحياة السياسية وتعطي للحقل السياسي الدينامية المطلوبة، ساهم بدوره في خلق نوع من الجمود السياسي.[16]
لذلك، مازال المغرب يُصنف ضمن الأنظمة الهجينة، رغم مرور أكثر من عقدين على الإصلاحات الدستورية والسياسية وما رافقها من سرديات من قبيل «التناوب التوافقي»، «الانتقال الديمقراطي» و«العهد الجديد»؛ حيث صنفه تقرير صادر في 2020 عن مؤسسة «ايكونوميست أنتليجنس يونيت» البريطانية، ضمن قائمة الأنظمة السياسية «الهجينة»، بعدما حل في المرتبة السادسة والتسعين، من أصل 167 بلدًا شملها التصنيف. وحصوله على خمس نقاط وأربعة من مئة من أصل عشر نقاط. كما لم يحرز هذا النظام نقاطًا جيدة ضمن الجوانب الخمسة التي درسها المؤشر، إذ حصل على معدل خمس نقاط وخمسة وعشرين من مئة من أصل عشر نقاط فيما يتعلق بالانتخابات التعددية. وفيما يتعلق بالأداء الحكومي حصل على أربع نقاط وأربع وستين من مئة، وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية حصل على خمس نقاط وست وخمسين من مئة؛ ناهيك عن كونه لم يتجاوز معدل أربع نقاط واثنتي عشرة من مئة فيما يتعلق بالحريات المدنية، في مقابل خمس نقاط وثلاثة وستين من مئة بخصوص الثقافة السياسية.[17]
مصطلح «النظام الهجين» يشير لتلك الأنظمة السياسية المتنوعة التي تجمع بين بعض العناصر الديمقراطية وبعض العناصر السلطوية بشكل كبير؛ بحيث لا تعتمد شرعية حكم هذه الأنظمة الهجينة على الإرادة الإلهية أو الأصول الأسرية، ولا تلجأ إلى العنف الشديد والإكراه للاحتفاظ بالسلطة بالقدر نفسه الذي تعتمده الأنظمة الاستبدادية الكلاسيكية.[18] ومن خصائص هذه الأنظمة الهجينة تفكك حدود التعددية بداخلها أو تحديدها المسبق لتعددية سياسية مفتوحة مع القليل من الديمقراطية، وكذا عجز هذه الأنظمة عن تثبيت مؤسساتها.[19]
فرغم التحول الكبير الذي أحدثته الموجة الثالثة من الديمقراطية في البنيات السياسية في الكثير من بلدان العالم النامي، إلا أن عملية التحول الديمقراطي هذه تخضع لمسارات متعرجة ومختلفة، تكون غالبًا مشدودة لتجربتها التاريخية وما راكمته من بناء مؤسسي.
عندما وصل الملك محمد السادس للعرش سنة 1999، وجد أمامه نظامًا سياسيًا بدأ يخضع لعملية «التهجين»، وذلك بفعل الانفتاح السياسي الذي أطلقه نظام والده الحسن الثاني مع بداية التسعينيات من القرن الماضي، بتقديمه جملة من الإصلاحات الحقوقية، من قبيل تضمين دستور 1992 أن المملكة المغربية تتشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميًا، والعفو سنة 1994 عن العديد من المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال فيما بات يُعرف بـــ«سنوات الرصاص» في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.[20] وذلك في ظل مناخ دولي جديد يدعم قيم الديمقراطية، بالإضافة لضغوط البرلمان الأوربي الذي رفض منح مساعدات للمغرب؛ بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان.[21]
جاءت هذه الإصلاحات الحقوقية في ظل إرث ثقيل من الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان خلال «سنوات الرصاص»، حيث لم يوجه العنف الدولتي بحق الذكور فحسب، وإنما طال النساء والأطفال أيضًا. ورغم التضحيات الكبيرة التي قدمتها النساء، من أجل تحرير بلدها وتحملها إذلال المستعمر وعنفه، أضحت المرأة المغربية بعد الاستقلال منبوذة سياسيًا، كما كانت عرضة للانتهاكات والعزل التمييزي في مجتمعها، بالإضافة إلى تعرضها للانتهاك السياسي ليس فقط بسبب نشاطها السياسي وتمردها، ولكن أيضًا بسبب جنسها الأنثوي.[22]
ومثّل وصول الملك محمد السادس للحكم سنة 1999، نقطة تحول كبير في إرساء سياسة الانفتاح السياسي، من خلال قيادته الدولة بطريقة «متجددة» و«حديثة»؛ إذ تميز عهده بإصلاحات ليبرالية مهمة، فعمل على إتمام مشروع تعديل مدونة الأسرة الذي بدأه والده قبل وفاته بشهور. ومن بين أهم الإصلاحات التي تضمنها هذا المشروع التحديثي، رفع سن الزواج من خمس عشرة إلى ثمان عشرة سنة، كما خوّل للمرأة حق الطلاق بالتراضي، وحدَّ من حق الرجال في طلب الطلاق بشكل انفرادي، فضلًا عن وضعه قيودًا على تعدد الزوجات.[23]
ورغم أن هذه الإصلاحات التحديثية أخرجت النظام السياسي المغربي من شرنقة الأنظمة السلطوية المغلقة، وأدخلته إلى نادي السلطويات المرنة أو الأنظمة الهجينة، إلا أنها كانت مجرد إصلاحات سطحية لم تقد إلى خلخلة البنية السلطوية للنظام السياسي؛ إذ لا تزال المؤسسة الملكية مهيمنة على البنيان الدستوري، وعلى صناعة القرار. وعلى الرغم من الإصلاحات الدستورية المهمة لسنة 2011 والتي جاءت في سياق «الربيع العربي»، الذي كان موسومًا بالطلب على التغيير السياسي والمؤسساتي، ظلت المؤسسة الملكية فاعلًا مركزيًا داخل الحقل السياسي، الأمر الذي عكسته حجم الصلاحيات والسلطات الممنوحة لها، سواء باعتبار الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى (الفصل الثاني والأربعون)، أو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشئون الدينية (الفصل الحادي والأربعون من دستور 2011).[24]
النسوية المغربية واختراق الفضاء العام
لم تستطع المرأة المغربية اختراق البنية الحزبية «الحديدية»، حيث ظلت على هامش الترتيبات المؤسسية للأحزاب السياسية، حتى تلك التي تدعي الحداثة والديمقراطية منها، وهو ما يعود في المقام الأول إلى ثقل الزمن الطويل على الذهنيات والممارسات؛ إذ لم يسعف هذه التنظيمات السياسية خطابها السياسي «الحداثي» في التخلص من الموروث الثقافي الذكوري، الذي طبع ثقافتها السياسية، بحيث أن البنية الذهنية التقليدية للمجتمع ظلت متحيزة للرجل أكثر من المرأة، وهو ما تظهره الهندسة الذكورية لمعظم حقول الحياة اليومية.
يطرح هذا التشييد الذكوري للفضاء العام تحديات كبيرة على المشاركة السياسية النسائية في الشئون العامة، إذ كثيرًا ما يُنظر إلى النساء بعين الريبة إزاء كل مبادرة سياسية من شأنها اختراق الفضاء العام. بل، كثيرًا ما يتم اعتبارهن غير قادرات على تحمل المسئولية العامة. تطرح هذه التصورات النمطية، التي شيدتها ثقافة ذكورية تقليدية، بعض الصعوبات على الأحزاب السياسية في دعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز حضور المرأة في قلب الحياة السياسية.
أدى استبعاد النساء من المجال السياسي، ومن إدارة الشأن العام في المغرب، إلى انخراطهم في عمل الجمعيات كآلية من آليات المقاومة؛ لفرض نفوذهم وتنازعهم السياسي. ومهد ذلك لظهور وتشكيل القضية النسائية، من خلال تشكيل وتطوير جمعيات نسائية مختلفة تناضل من أجل المرأة ومن أجل الوعي بوضعها ومكانتها وتطورها ودورها داخل المجتمع.[25] وذلك، من خلال رفع وعيها بالقضايا المتعلقة بالتعليم والمعرفة، وبالقوانين التي قد تعوق أو تقيد ولوجها للفضاء العام كقانوني الأسرة والشغل؛ بحيث ساهمت هذه الدينامية المدنية بشكل كبير في خلق خطاب نسوي يعتمد على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
جاء بروز المنظمات النسائية في المغرب كرد فعل على أزمة نموذج الدولة الوطنية التي لم تستطع الالتزام بوعود التحديث السياسي والمجتمعي بعد الاستقلال؛ إذ عملت هذه المنظمات على إثراء الفضاء العام بخطاب حقوقي يناصر قضايا النساء. الأمر الذي ساهم في خلق دينامية اجتماعية من خلال تعبئة المضطهدات من النساء. كما لعبت هذه المنظمات دورًا مها في الكفاح ضد كل أشكال اللامساواة بين الجنسين، فضلًا عن تسليطها الضوء على قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحدي التفكير التقليدي والممارسات القمعية والمتحيزة جنسيًا. طرحت هذه الدينامية الاجتماعية الجديدة تحديات جديدة على سياسات التنمية الحكومية، وفتحت آفاقًا جديدة للتفكير في قضايا النوع الاجتماعي.[26]
لم تكن الحركة النسائية في المغرب على هامش الصراع المجتمعي، إذ دفعتها التحولات السياسية، التي عرفها المغرب مع مطلع التسعينيات، إلى المطالبة بإصلاحات مؤسسية وتشريعية، من خلال إطلاقها لعريضة مليون توقيع سنة 1992، بمبادرة من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أثناء مؤتمرها في نهاية ديسمبر 1991 في الرباط، وهي عريضة تطالب بتغيير مدونة الأحوال الشخصية، وكانت هذه الدينامية النسائية الجديدة بمثابة انتقال من مرحلة البناء التنظيمي والتأسيس الفكري والإيديولوجي للقضية النسائية إلى مرحلة النضال المطلبي والترافع من أجل تعزيز حقوق النساء وفق ما هو متعارف عليه دوليًا في منظومة حقوق الإنسان.[27]
هذه الدينامية النسائية الجديدة دفعت حكومة السيد عبد الرحمن اليوسفي عام 1999، للإعلان عن مشروع «الخطـة الوطنية لإدماج الـمرأة في التنمية» التي أعدها الوزير المكلف بالنهوض بأوضاع المرأة السيد «سعيد السعدي»، بمشاركة فعاليات نسائية متشبعة بالحداثة واعتماد المواثيق الدولية التي تناهض كافة أشكال التمييز ضد النساء (cedaw).[28] ويهدف هذا المشروع لتعزيز مكانة المرأة في مجال التربية ومحو الأمية والصحة الإنجابية، وإدماج المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مكانتها قانونيًا.[29]
رغم الرهان التحديثي لهذا المشروع، إلا أنه قوبل بمقاومة شرسة من الحركة الإسلامية المغربية، لاسيما الشق المتعلق بالأحوال الشخصية والأسرة، وهو ما قادها لتنظيم مسيرة حاشدة بالدار البيضاء في العاشر من مارس سنة 2000. الأمر الذي دفع القوى الحداثية للرد بمسيرة مضادة في العاصمة الرباط لمساندة مشروع الخطة الوطنية.
هذا الاستقطاب الحاد بين الحداثيين والمحافظين مثّل أزمة حقيقية لوضع إصلاحات من شأنها تحسين الشرط المؤسسي والحقوقي للمرأة، الأمر الذي دفع بعض التنظيمات النسائية لطلب التحكيم الملكي، الذي عمل على تعيين لجنة استشارية متعددة الاختصاصات؛ لاقتراح مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية تراعي التحولات الاجتماعية التي يعيشها البلد، والتوجهات الاجتماعية والثقافية التي تخترق المجتمع المغربي. الأمر الذي عبّر عنه الملك محمد السادس في خطاب له سنة 2003 بقوله «فضلًا عما اتخذناه للنهوض بأوضاع المرأة وإنصافها، فإننا لم نتردد في تجنيب المجتمع مغبة الفتنة حول هذه القضية».[30]
تشكل الوظيفة التحكيمية إحدى الآليات التقليدية لحل الخلافات بين مختلف الفرقاء السياسيين، فتسمح بالحفاظ على التوازن وحماية الوضع القائم، كما تعد آلية لبسط نفوذ المؤسسة الملكية على الحقل السياسي. طيلة مسارها التاريخي لعبت المؤسسة الملكية دورًا تحكيميًا، إذ ساهمت الطبيعة «الانقسامية» التي تعتري المجتمع المغربي في تطور هذه الوظيفة.[31] إن الدور التحكيمي للمؤسسة الملكية ليس وليد التجربة السياسية التي رافقت الدولة المغربية الحديثة بعد الاستقلال، بقدر كونه ممارسة تقليدية تجد جذورها التاريخية في بنية المخزن كنظام للتحكيم والموازنة.[32]
الكوتا النسائية كسياسة جديدة
يعد نظام «الكوتا» إجراءً إيجابيًا يهدف لمعالجة نقص تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية، وتم تبنيه في الأصل من جانب الأحزاب السياسية في النرويج خلال السبعينيات، ومنذ ذلك الحين أضحى أحد أسرع الاتجاهات القانونية التي عرفت ازدهارًا وانتشارًا كبيرًا في مناطق وسياقات سياسية مختلفة من العالم. فضلًا عن كونه طرح العديد من السجالات الفكرية والسياسية عندما تم التفكير فيه كآلية سياسية يمكن اعتمادها لتحسين الشرط السياسي للمشاركة النسائية، ومن بين التفسيرات التي قدمت هي أن نظام «الكوتا» يسمح بخلق تعبئة سياسية للمرأة، ويمنح الحوافز الاستراتيجية للنخب السياسية، كما أنه يجعل من المعايير السياسية القائمة متسقة مع السياسات والمعايير الدولية للمشاركة السياسية.[33]
ومثّل الضغط الدولي من أجل المشاركة السياسية للمرأة فرصة سياسية للمنظمات النسائية؛ لرفع وعي المرأة بأهمية المطالبة بحقوقها السياسية، وتحسين شرطها التمثيلي داخل المؤسسات المنتخبة، التي لطالما خضعت للهيمنة الذكورية. في ظل هذا السياق تم طرح مسألة «الكوتا النسائية» من جانب المنظمات النسائية؛ استجابةً للتطور الدولي لمفاهيم المساواة بين الجنسين. وتعتبر المنظمات النسائية في المغرب من أهم الداعمين الداخليين لحقوق المرأة. وهو ما تم التعبير عنه عند تشكيل «لجنة مشاركة المرأة في الحياة السياسية» عام 1993 في الدار البيضاء.[34]
شكّل مطلب التمكين السياسي للمرأة، هاجسًا لدى المنظمات النسوية في المغرب منذ بداية تسعينيات القرن الماضي؛ إذ تقدمت للسلطات المعنية بمقترحات لتشجيع تمثيلية المرأة، من قبيل ضمان عشرة في المائة على الأقل من الترشيحات النسائية. لقد كان إصلاح قانون الانتخابات في صيف 2002 فرصة سياسية لها لرفع مطالبها بزيادة المشاركة السياسية للمرأة، من خلال رفعها لمذكرة مطلبية موسومة بـ«مشروع مراجعة القانون الانتخابي»؛ بغية تحسين الشرط المؤسسي للمرأة داخل مراكز القرار السياسي. وأرجعت هذه المذكرة أسباب ضعف التمثيل السياسي للمرأة لغياب الإرادة السياسية، واعتبرت أن تعديل مدونة الانتخابات، سيكون فرصة للحكومة للتعبير عن إرادتها الحقيقية من أجل تعزيز التمكين السياسي للمرأة.[35]
مارست المؤسسة الملكية داخل النظام السياسي المغربي دورًا محوريًا وحاسمًا في تعزيز القضايا الحقوقية للمنظمة النسائية، بحيث كانت النخب الحاكمة في المغرب تدرك جيدا أن إشراك المرأة في الحياة السياسية عن طريق نظام الكوتا له عوائد سياسية مهمة، من بينها تعزيز شرعية المؤسسات السياسية داخليًا، وجني ثماره السياسية خارجيًا في ظل مناخ عالمي أضحت فيه فكرة المساواة بين الجنسين قضية بارزة بشكل متزايد، كما أصبحت دليلًا على المشروعية الديمقراطية والحداثة السياسية.
المكانة المركزية للملك في النظام السياسي المغربي شجعت الحركة النسائية على المطالبة بنظام «الكوتا»، لا سيما بعد الخطاب الثاني للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لثورة الملك والشعب في العشرين من أغسطس 1999، الذي جاء فيه «كيف يتطور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره. والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تُهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق، هن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف، مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور، سواء في ميدان العلم أو العمل».[36]
في سياق سردية «العهد الجديد» التي رافقت وصول الملك محمد السادس للعرش سنة 1999، كانت الانتخابات التشريعية لعام 2002 أول اختبار لنوايا التغيير السياسي؛ بحيث التزمت القوى السياسية بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. مع تعزيز ذلك بإصلاحات سياسية وانتخابية تستهدف تحسين شرط المشاركة السياسية؛ من أجل رفع نسبة مشاركة المواطنين المغاربة في الانتخابات، واستعادة ثقتهم في السياسة المغربية. وكان من بين الإجراءات التي تم اتخاذها تخفيض سن الاقتراع من عشرين إلى ثمان عشرة سنة، واعتماد نظام كوتا خاص بالنساء بنسبة عشرة في المائة من المقاعد النيابية.
فتحت فرصة التمكين السياسي للنساء المغربيات من خلال نظام «الكوتا» مسارًا تصاعديًا في المشاركة السياسية، إذ لم يستطعن الولوج إلى المؤسسة البرلمانية إلا في سنة 1993، بعدما تمكنت امرأتان من دخول المؤسسة التشريعية بمجلس النواب بعد فوزهما بمقعدين؛ وهو ما سلط الضوء على ضرورة رفع الحيف والتهميش، والتفكير في آليات سياسية تعزز حضورهن بالمؤسسات المنتخبة.[37] في ظل هذا السياق، تبنى المغرب «كوتا» توافقية للنساء، بعد تعديل القانون التنظيمي رقم 02.29 المتمم والمغير للقانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الذي نص على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى صنفين، دوائر انتخابية محلية تضم 295 مقعدًا، وأخرى وطنية تضم ثلاثين مقعدًا تم التوافق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية على تخصيصها للنساء.[38]
وأدى هذا التوافق لوصول خمس وثلاثين امرأة للبرلمان سنة 2002، وهو تحول نوعي في حجم التمثيلية التي ارتفعت من ست من عشرة بالمئة في الولايتين التشريعيتين (1993-1997) إلى عشرة وثمانية من عشرة بالمئة عقب انتخابات 2002. وبهذا انتقل المغرب من المرتبة 111 في قائمة البلدان ذات التمثيلية البرلمانية للنساء إلى المرتبة 69 عالميًا. إلا أنه، مع انتخابات السابع من سبتمبر 2007 تراجعت أعداد المنتخبات من خمس وثلاثين إلى أربع وثلاثين امرأة؛ وهو تراجع كمي قد يبدو طفيفًا، لكن بوضعه في إطار المقارنة على المستوى الدولي فقد كان تأثيره قويًا، حيث نقل المغرب من المرتبة الثانية إلى المرتبة السابعة على المستوى العربي، وإلى المرتبة الثامنة والتسعين على المستوى الدولي.[39]
الربيع العربي كفرصة لتعزيز الشرط السياسي للنساء
كان لأحداث الربيع العربي، وما رافقها من إصلاحات دستورية وتشريعية واسعة، فرصة سياسية كبيرة للحركة النسائية المغربية لتقديم تصوراتها ومطالبها، للجنة الاستشارية لتعديل الدستور التي اختلفت منهجية عملها عن الطرق السابقة في إعداد الوثيقة الدستورية. لكن لُوحظ أن الطرح الذي تقدمت به الحركة النسائية لم يتجاوز الإجراءات الشكلية للتمكين السياسي، دون نفاذ تصوراتها إلى عمق إشكالية الديمقراطية،[40] باعتبارها الضمانة الأساسية لتداول السلطة وصناعة القرار الحر.
وتأثر دستور سنة 2011 بالسياق الاحتجاجي الذي عرفه العالم العربي، والذي لم يكن المغرب بمعزل عنه، لذلك جاء الدستور برزمة من الحقوق والحريات الأساسية؛ اتساقًا مع المطالب التي كثّفها المحتجون في الثلاثي الآتي: «حرية»، «كرامة» و«عدالة اجتماعية»، هذا ما جعل المشرع الدستوري يغير الفصل 19 من دستور 1996 بحمولاته الرمزية التقليدية، إلى فصل وُصف بــ«الحداثي والتقدمي»، بحيث نص على أن «الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية». مع تأكيده على أن الدولة «تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحْدَثُ لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز».[41]
كما تم تعزيز هذا المسار الإصلاحي بقانون تنظيمي، تضمّن مقتضيات من شأنها دعم التمثيلية النسوية وتمثيلية الشباب بمجلس النواب، حيث تم تخصيص المقاعد الموجهة للدائرة الانتخابية الوطنية للترشيحات المقدمة من طرف النساء والشباب الذكور، الذين لا يتجاوز سنهم أربعين سنة، مع وضع الآلية التشريعية اللازمة لضمان انتخاب ستين مترشحة على الأقل وثلاثين مرشحًا شابًا برسم هذه الدائرة من إجمالي 395 مقعدًا.[42] فضلًا عن ذلك تم تعزيز وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في سنة 2012 بإضافة قطاع المرأة لمسئولياتها، وبهذا تحول اسمها إلى «وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والمرأة».
ورغم المكتسبات التي منحها دستور 2011 للنساء المغربيات، إلا أن الممارسة السياسية ظلت محكومة بتبعية المسار، حيث كان نصيب المرأة في أول حكومة بعد دستور 2011، وزيرة واحدة عن حزب العدالة والتنمية، وهي السيدة بسيمة الحقاوي من ضمن واحد وثلاثين وزيرًا. دفع هذا الوضع الانتكاسي المنظمات النسائية المغربية للتنديد بهذا التراجع؛ وهو ما اعتبره البعض تراجعًا عن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في السنوات السابقة، حيث شغلن سبع حقائب في الحكومة التي قادها حزب الاستقلال سنة 2007.
الكوتا النسائية آلية للتمكين السياسي أم سقف زجاجي؟
تُظهر بعض الأبحاث حول نسوية الدولة أن الأنظمة غير الديمقراطية تسن غالبًا سياسات صديقة للمرأة بغرض الحفاظ على السلطة، وليس بهدف تحقيق تمكين سياسي حقيقي.[43] لذلك تصبح سياسة النوع أداة لخلق سقف زجاجي للمرأة داخل المؤسسات المنتخبة؛ وهو ما يجعل سياسة المقاعد المحجوزة لها تأثير ضعيف على مخرجات التمكين السياسي الفعلي.
لقد جادلت «كروك منى لينا» بكون إعمال سياسة المقاعد المحجوزة في التجربة السياسية المغربية زاد من التمثيل الوصفي للمرأة، ولكنه أدى في الوقت نفسه لإدخال سقف زجاجي جديد،[44] يجعل من التمثيل السياسي للمرأة تمثيلًا رمزيًا؛ بحيث استطاع نظام الكوتا في خلال عقدين من الممارسة زيادة الإدماج العددي للمرأة في المؤسسة البرلمانية، ومع ذلك يبقى هذا التمثيل كميًا وليس نوعيًا؛ إذ تصبح «الكوتا» وحدها غير كافية لتأمين التمثيل السياسي الحقيقي للمرأة المغربية؛ وهو ما تعكسه نسبة التمثيل الضعيفة للمرأة في اللوائح المحلية.
جدول (1)
تطور التمثيلية النسائية بمجلس النواب المغربي بين سنة 1977 و2021[45]
| التاريخ | عدد المرشحات | عدد الفائزات | النسبة |
| 1977 | 08 | 00 | 00 |
| 1984 | 15 | 00 | 00 |
| 1993 | 33 | 02 | 06 % |
| 1997 | 69 | 02 | 06 % |
| 2002 | 964 بينهن 266 محليًا و698 عن طريق اللائحة الوطنية | عدد الفائزات 35 بينهن 05 في الدائرة المحلية و 30 عن طريق الكوتا | 10.8 % |
| 2007 | 780 في اللائحة الوطنية(الكوتا) الترشيحات المحلية غير متوفرة | عدد الفائزات 34 منهن 04 في الدائرة المحلية و 30 عن طريق الكوتا | 10.6 % |
| 2011 | 1624 منها 464 محلي و1160 عن طريق اللائحة الوطنية | عدد الفائزات 67 منهن 07 في الدائرة المحلية و 60 عن طريق الكوتا | 17 % |
| 2016 | غير متوفرة | عدد الفائزات 81 منهن 10في الدائرة المحلية و 71 عن طريق الكوت | 21.18 % |
| 2021 | 2329 | عدد الفائزات 95 منهم 05 في الدائرة المحلية و 90 عن طريق الكوتا | 24.3 % |
يُظهر الجدول السابق أن زيادة التمثيلية النسائية بمجلس النواب كان من نصيب اللوائح الوطنية المخصصة للنساء، إذ ازداد عدد البرلمانيات بشكل ملفت بين سنة 2002 و2021، الأمر الذي يعكس الدينامية والتعبئة التي خلقها نظام «الكوتا»؛ لاسيما أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11 الذي جاء في سياق الإصلاحات الدستورية والقانونية لما بعد الحراك المغربي لسنة 2011 قد رفع من عدد المقاعد المحجوزة للنساء من ثلاثين مقعدًا إلى ستين مقعدًا من بين 395 مقعدًا يتألف منها مجلس النواب، وذلك عكس اللوائح المحلية التي ظلت شبه ثابتة. تتأثر القواعد الانتخابية بالمغرب بطبيعة اللعبة السياسية التي تفتقد للكثير من المقومات الديمقراطية؛ لذلك، تمنع الترتيبات المؤسسية البرلمانيات من بناء دائرة انتخابية محلية يمكن الاستفادة منها لضمان دعم انتخابي وسياسي دائم.
يبدو أن سياسة التمكين عن طريق «الكوتا» لم تحدث العدوى من خلال زيادة عدد النساء المنتخبات في الدوائر المحلية؛ وهو ما أدى إلى إدخال «سقف زجاجي جديد»، يمنع النساء من الترشيح والانتخاب بما يتجاوز متطلبات «الكوتا». كما لم يسعف هذا النمط التمثيلي الهش العديد من المنتخبات اللواتي نجحن عبر آلية «الكوتا» أن يتم انتخابهن لاحقًا في مقاعد الدوائر المحلية. هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار تصميم نظام «الكوتا» المغربي الذي يمنع النساء من البقاء في مجلس النواب؛ بحيث لا يُسمح لهن بالحصول على مقعد ضمن اللائحة الوطنية إلا مرة واحدة.
وهذا ما عبرت عنه إحدى البرلمانيات السابقات عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ذو الخلفية اليسارية، بقولها «تم انتخابي على اللائحة الوطنية للمرأة. بعد ذلك، لم يُسمح لي بالترشح مجددًا على اللائحة نفسها. وهكذا ترشحت على مستوى اللائحة المحلية في منطقة أخرى، لكن عدم حصولي على الدعم من الحزب أو من النساء الأخريات، فضلًا عن ترشحي ضد وزير سابق جعلني أخسر». مؤكدةً أن «الافتقار إلى الدعم الحزبي يثني النساء بشكل غير مباشر عن الترشح في المناطق المحلية».[46]
تمكين سياسي أم إصلاح سطحي؟
إذا كان نظام «الكوتا»، بمثابة فرصة سياسية للمرأة المغربية لتحسين تمثيليتها المؤسسية والسياسية، والتي أبرزها الارتفاع المتزايد للنساء البرلمانيات من أحد عشر بالمئة في الانتخابات التشريعية لسنة 2002، إلى واحد وعشرين وثمانية عشرة من مئة بالمئة في انتخابات مجلس النواب لسنة 2021. ومع ذلك، تبقى نسبة ضعيفة جدًا إذا ما قورنت مع بعض الأنساق الدولتية القريبة من المغرب.
جدول (2)
ترتيب الدول المغاربية في نسب تمثيل المرأة في البرلمانات[47]
| الدولة | عددالنساء | عددالنواب | النسبةالمئوية | الترتيب المغاربي | الترتيب العربي | الترتيب الأفريقي | الترتيب العالمي |
| الجزائر | 119 | 462 | 25.8 | 2 | 3 | 16 | 65 |
| تونس | 76 | 217 | 35 | 1 | 1 | 11 | 43 |
| المغرب | 81 | 395 | 20.5 | 3 | 9 | 25 | 94 |
بقدر ما كانت فكرة «الكوتا» النسائية، فكرة جذابة ومغرية للحركة النسائية المغربية للولوج للفضاء السياسي المسيج، بقدر ما وجدت نفسها أمام مؤسسات حزبية تفتقد للممارسة الديمقراطية الداخلية، الأمر الذي عبر عنه الأستاذ فريد المريني بقوله «إن غياب الديمقراطية داخل الأحزاب المغربية ظاهرة عامة»، وهي تعكس في نظره «مسألة الفراغ الأيديولوجي، وغياب المشاريع السياسية الحقيقية والمستقلة. وليس من قبيل المصادفة ملاحظة أن أغلب الصراعات الحزبية الداخلية، تنطبع بطابع شخصي ويتحكم في تدبيرها منطق الولاءات الكريزماتية أو العشائرية، أكثر مما تخضع لمنطق المسطرة القانونية ولثوابت الإدارة الديمقراطية».[48]
تشكل البنية المؤسسية للأحزاب السياسية عائقًا أمام التنفيذ السليم للمشاريع والمبادرات التي من شأنها دعم مشاركة المرأة في الهياكل السياسية، ولم تستثن هذه الأعطاب الأحزاب التي تقدم نفسها باعتبارها حداثية وتقدمية. ورغم أن هذه الأحزاب ترفع في خطاباتها وشعاراتها الانتخابية المطالبة بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية؛ إلا أن هذه الشعارات ما فتئت تسقط أمام طموحات القيادات الذكورية في الحصول على المناصب السياسية. وهذا ما دفع المناضلة النسائية خديجة الرباح إلى التعبير على أنه «شتان بين الخطاب والممارسة، الخطاب الذي يتحدث عن المساواة والممارسة التي لا تزال بعيدة كل البعد عن تفعيل ذلك».[49]
إن عرقلة وصول النساء إلى مناصب المسئولية، لم يقف عند حدود ترشيحهن عن طريق «الكوتا» كما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل، بل كثيرًا ما يتم التحايل عليهن على مستوى تحمل المسئولية سواء على مستوى الرئاسة أو على مستوى الإنابة عن طريق الضغط على المترشحات بتقديم التنازلات في محاضر تثبت عدم رغبتهن في تحمل المسئولية، وهذا «يعتبر تراجعًا وضربًا للمسار النضالي للحركة النسائية، وإخلالًا بمقتضيات الدستور، ويكشف مدى إصرار العقليات الذكورية على حصر المرأة في الأدوار الاجتماعية فقط».[50]
ورغم أن المادة الـسابعة عشرة من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تنص على أنه «يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددًا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس»، فإن عددًا من النساء عبرن عن رفضهن تولي المسئولية، وتركنها للذكور كما حدث في انتخابات المجلس الجماعي لمدينة الرباط؛ حيث تم الاكتفاء بنائبتين للرئيسة بدلًا من أربعة كما ينص القانون. وحسب مستشارة جماعية في مدينة الرباط، لم ترغب في الإفصاح عن اسمها، فإن الأمر «لم يكن باختيار النساء؛ بل خضع لاتفاقات قبلية من أجل المحافظة على التحالف القائم، وأن النساء يلتزمن في أغلب الأحيان بتوجيهات أحزابهن».[51]
وهذا ما تم تأكيده من جانب بعض النائبات البرلمانيات اللواتي صرحن للباحثة «ضهور حنان» أن «نظام الكوتا يجعل المرأة بارزة، ولكن على هامش العديد من القضايا السياسية الصعبة». كما شددن على «أن آليات إصلاح نظام الكوتا تشير مباشرة لمبادئ العمل الخيري، ولا توحي بأي حال من الأحوال باحترام حقوق الإنسان الأساسية للمرأة».[52] كما أعربت مستشارة محلية عن استيائها في تصريح للباحثة «حنان» من نظام الحصص بين الجنسين، بقولها «أين نحن من المساواة والتكافؤ؟ مواقف الأحزاب السياسية والمجتمع سلبية. نحن نعتبر الكوتا هدية ونحن (النساء) مثل الديكور. لا نتحمل أي مسئولية ونقتصر على اللجان الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية. إن المحسوبية هي التي تسود (بنت، أخت، ابنة…) على هذا المستوى تم تقسيم كل شيء؛ الطريق إلى المساواة لا يزال طويلًا جدًا».[53]
فضلًا عن ذلك، اتجهت بعض الأحزاب السياسية لتكريس «الريع السياسي» في اختيار المرشحات ضمن اللوائح الانتخابية، من خلال اعتماد معيار القرابة العائلية، إذ كثيرًا ما استغلت بعض القيادات الحزبية آليات التمكين السياسي لوضع زوجاتهم وبناتهم وقريباتهم على رأس اللوائح الانتخابية للحصول على مقاعد برلمانية، وهو ما يظهره الجدول الآتي:
جدول (3)
شبكة العلاقات العائلية للنائبات البرلمانيات خلال الولاية التشريعية 2011-2016[54]
| اسم البرلمانية | الحزب السياسي | طبيعة علاقة القرابة |
| حنان أبو الفتح | التجمع الوطني للأحرار | ابنة أخت المعطي بنقدور القيادي بالحزب |
| مينة بوهدهود | التجمع الوطني للأحرار | ابنة القيادي في الحزب بوهدهود بودلال |
| رحمة طريطاح | التجمع الوطني للأحرار | ابنة القيادي في الحزب أحمد طريطاح |
| زينب قيوح | حزب الاستقلال | ابنة القيادي في الحزب علي قيوح وأخت الوزير السابق عبد الصمد قيوح |
| فاطمة طارق | حزب الاستقلال | زوجة الأمين العام للحزب حميد شباط |
| ياسمينة بادو | حزب الاستقلال | ابنة القيادي السابق عبد الرحمان بادو وزوجة علي الفاسي الفهري القيادي في الحزب |
| رقية الدرهم | حزب الاتحاد الاشتراكي | أخت القيادي بالحزب حسن الدرهم |
| خديجة اليملاحي | حزب الاتحاد الاشتراكي | زوجة النائب البرلماني عبد الهادي خيرات |
| حسناء أبو زيد | حزب الاتحاد الاشتراكي | زوجة القيادي في الحزب علي سالم الشكاف |
| جميلة عفيف | حزب الأصالة والمعاصرة | زوجة القيادي بالحزب الحبيب بن الطالب |
| رقية الرميد | حزب العدالة والتنمية | أخت القيادي بالحزب مصطفى الرميد |
يبدو من خلال شبكة العلاقات العائلية للنائبات البرلمانيات التي تم التوقف عندها أعلاه، أنه تم تحويل آلية التمكين السياسي والنهوض بالتمثيلية النسائية في البرلمان، لآلية لإعادة الإنتاج الاجتماعي بلغة عالم الاجتماع الفرنسي «بيير بورديو»؛ بحيث تم تحويلها من مؤسسة تشريعية لتمثيل الأمة إلى برلمان «عائلي» يحضر فيه الزوج وزوجته وأخته وابنته… وهو ما يبين أن نظام «الكوتا» تأثر عند تفعيله داخل الفضاء السياسي والمؤسسي المغربي، بطبيعة النسق الزبائني والريعي للمؤسسات التي تحتضن هذا التمكين.
وهو ما أكدته إحدى المناضلات النسويات المغربيات اللواتي ناضلن من أجل اعتماد نظام «الكوتا»، بقولها «حتى لو طالبت النساء برفع نسبة التمثيل عن طريق الكوتا، فإن الترشيح للوائح يضع النساء وجهًا لوجه مع النظام الأبوي الجديد الذي تمثله الأحزاب السياسية في المغرب. الذي يجعل «الكوتا» بمثابة «مظلة» للزوجات أو لغيرهن من الأقارب المقربات لقادة الأحزاب، بحيث يظهرن فجأة على رأس لائحة النساء». كما اعتبرت أيضا أن «التعيين في المناصب الحزبية يخضع لدرجة عالية من المركزية، ما يحول دون إنشاء دوائر انتخابية مستقلة داخل الأحزاب السياسية ويعزز سيطرة المركز والممارسات الموروثة».[55]
يظهر مما سبق، أن المتحكم في وضع النساء في المراكز المتقدمة من اللائحة الوطنية ليست هي النضالية أو الكفاءة أو المسار السياسي أو حتى الأصل الجغرافي، بل هو شبكة العلاقات الذكورية بالأساس القادرة على إنتاج وضعيات متقدمة للنساء في اللائحة الوطنية، ومنه الفوز بمقعد برلماني بأقل عناء ممكن.[56] هذا ما أكدته تصريحات بعض مناضلات حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري اللاتي اعتبرن أن «النساء المنتخبات من خلال نظام الكوتا غالبًا ما يتم تصويرهن على أنهن «رموز» أو «نساء بالوكالة» ليس لديهن سلطة سياسية حقيقية، لأنهن يدن في كثير من الأحيان باختيارهن لحزبهن السياسي أو روابطهن الأسرية، لا سيما لآبائهن أو أزواجهن».[57]
وهذا ما أكدته النتائج التي توصل إليها «لورين»[58] الذي صرح بأن المقاعد المحجوزة يُنظر إليها على أنها آلية تخدم سياسة المحسوبية، كما أنها تعزز أهمية الروابط الأسرية وتأثير القائد. وتماشيًا مع هذا الطرح، تؤكد «مونية بناني الشرايبي» أن اختيار المرشحات للقائمة الوطنية المخصصة للنساء لا يكافئ فعاليتهم ونشاطهم بل يخضع لمنطق الزبائنية.[59]
لم تكن النزعة الزبائنية للنظام الحزبي بالمغرب وليدة اليوم، بقدر ما هي ذات طبيعة بنيوية، طبعت مساره، وهذا ما عبر عنه الباحث الأمريكي «ويليام زرتمان» بقوله أن النضال من أجل الاستقلال في المغرب لم يفرز أحزابًا أيديولوجية بقدر ما أفرز «أحزاب مصالح»، فالحزب «الزبوني» حسب زارتمان يشكل أحد ثوابت الحياة السياسية المغربية، فهو في نظره لا يقوم على أساس مذهبي واضح بقدر ما تحركه المصالح المشتركة والالتزامات المتبادلة.[60]
تمكين سياسي أم لبرلة بلا ديمقراطية؟
لم تكن سياسة التمكين السياسي للمرأة في التجربة السياسية المغربية، تمشي جنبًا إلى جنب مع تطلعات القوى السياسية في التغيير الديمقراطي؛ فبقدر ما كانت انتخابات السابع والعشرين من سبتمبر 2002، لحظة مهمة في مسار التمكين السياسي للنساء المغربيات، بحصولهن على ثلاثين مقعدًا في البرلمان، بقدر ما كانت انتكاسة للديمقراطية الفتية بالمغرب، وانهيارًا لسردية «الانتقال الديمقراطي» أو ما كان يصطلح عليه مغربيًا بــ«التناوب التوافقي»؛[61] إذ رغم حصول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري على الرتبة الأولى بخمسين مقعدًا في هذه الانتخابات؛ عيَّن الملك إدريس جطو ذو الخلفية التكنوقراطية يوم التاسع من أكتوبر 2002 وزيرًا رغم عدم انتمائه للأغلبية البرلمانية.
علاوةً على تعيينه ما يسمى بوزراء السيادة: وزير الداخلية، وزير الخارجية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية من خارج الأغلبية الحكومية، بمعنى لم يضعوا أنفسهم على محك الاختيار الشعبي، الذي يعد أحد مبادئ الديمقراطية الإجرائية. دفع هذا السلوك المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي لإصدار البيان الشهير حول «الخروج عن المنهجية الديمقراطية» يوم الثامن والعشرين من نوفمبر2003.[62]
ورغم الإصلاحات الهامة التي تضمنها القانون الانتخابي[63] الذي أطر انتخابات سبتمبر 2021 التشريعية، بهدف تعزيز التمكين السياسي للمرأة بمختلف المؤسسات السياسية المنتخبة؛ إذ نص هذا القانون على تعزيز حضور التمثيلية النسائية بمجالس العمالات والأقاليم، وذلك بمنحها ثلث المقاعد بهذه المجالس، فضلًا عن تخصيص ستين مقعدًا لمرشحات اللوائح الجهوية للأحزاب من أصل 395 مقعدًا برلمانيًا. إلا أن هذه المستجدات القانونية، تضمنت تعديلات أخرى وصفت بـــ«غير الديمقراطية»، كما هو شأن «القاسم الانتخابي الجديد»، الذي أصبح يحتسب على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس الأصوات الصحيحة المعبر عنها، هذا ما دفع الباحث «الباسك منار» وهو أحد المتخصصين في الانتخابات المغربية إلى التعبير عن استغرابه، حيث رأى في هذا التعديل «أمرًا شاذًا ولا أساس له في التجارب الدولية المقارنة».[64]
لا يمكن فصل مسألة التمكين السياسي للمرأة المغربية، عن قضية الديمقراطية، إذ يصعب إرساء مؤسسات سياسية فاعلة تعزز مسارات التمكين السياسي للنساء بشكل فعلي، دون وجود أرضية ومناخ يسمحان بالتداول على السلطة والوصول إلى مؤسسات صناعة القرار؛ إذ أن الأحزاب السياسية المغربية، كمؤسسات، لديها القليل من القوة السياسية لاتخاذ القرارات، والتعبير عن المصالح الاجتماعية داخل الحقل السياسي. بينما ظلت عملية صنع القرار المركزي في يد المؤسسة الملكية التي لا تنظر لنفسها كسلطة حاكمة فقط، بل عملت منذ الاستقلال على موضعة نفسها فوق الفرقاء السياسيين والاجتماعيين.[65]
التجارب السياسية المقارنة، خاصةً الأوربية منها، تؤكد أن قضية المرأة تقدمت وازدهرت في ظل أنظمة ليبرالية وديمقراطية، كما تعززت بالمقابل الديمقراطية باستيعابها في المؤسسات التمثيلية، ولم يكن ذلك ليتأتى لولا اعتماد آليات سياسية سواء بشكل إرادي كما هو حال أغلب الدول الإسكندنافية، أو بشكل قانوني كما هو الحال في أغلب دول العالم. غير أن طرح سياسة النوع في بيئة سياسية غير ديمقراطية، وطرحه كإشكال ديمقراطي داخلها، قد يشوه جوهر القضية، وتصبح قضية التمثيل السياسي للمرأة، إحدى الأدوات التي تبحث بها الأنظمة السلطوية على مصداقية أكبر لمؤسساتها السياسية.[66]
ومع ذلك، قد تبقى سياسة التمكين السياسي للمرأة فرصة سياسية لدفع هذه الأنظمة إلى التكيف مع متطلبات الديمقراطية، وهذا ما خلصت إليه عالمة السياسة «جينيفر غاندي» في كتابها الموسوم «المؤسسات السياسية في ظل الديكتاتورية»، بقولها «أن الهيئات التشريعية والأحزاب والحركات الاجتماعية يمكن أن يكون لها تأثير جيد على السياسة في الدول غير الديمقراطية، وأنه تحت الضغط قد تقدم القيادات السياسية تنازلات من أجل تحييد التهديدات ومواصلة التعاون».[67]
خاتمة
حاولت هذه الورقة التوقف عند تأثير الإصلاحات السياسية والحقوقية التي عرفها المغرب مع نهاية ثمانينيات القرن العشرين في النظام السياسي المغربي؛ إذ ساهمت هذه العوامل في دفع النظام للتكيف مع هذه الموجة الجديدة، من خلال القيام ببعض الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، والسماح بولوج النساء للمؤسسات المنتخبة عن طريق نظام «الكوتا» منذ أول انتخابات في عهد الملك محمد السادس سنة 2002، وتم تعزيز هذا المسار الإصلاحي بإصلاحات مهمة مع دستور 2011 الذي نص على مبدأ المناصفة أو من خلال توسيع مقاعد «الكوتا» النسائية في القوانين المؤطرة لعمل مجلس النواب التي أعقبت الحراك المغربي لسنة 2011. فضلًا عن إبرازها للدور الجوهري الذي لعبته الحركة النسائية المغربية لطرح قضايا المرأة في الفضاء العام، وعلى رأسها مسألة التمكين السياسي، سواء من خلال الترافع من أجل بلورة كوتا نسائية في سنة 2002 أو من خلال تعزيزها لهذا المطلب في مذكراتها في خضم الحراك العربي والمغربي لسنة 2011.
ورغم أهمية السياسات التي رافقت سياسة المقاعد المحجوزة للمرأة، في التجربة السياسية المغربية، إلا أن العديد من المراقبين الدوليين والباحثين شككوا في طبيعة هذه الإصلاحات، حيث لاحظوا أن هذه الإصلاحات ماهي إلا «ديمقراطية سطحية»، يسعى من خلالها النظام الهجين لتزيين واجهة نظامه دون إرساء قواعد التمكين السياسي على أسس ديمقراطية صلبة. تجد هذه الأطروحة صداها في طبيعة التمثيل الرمزي للمرأة، فبدايةً من الزيادة العددية للنساء المنتخبات في مجلس النواب، منذ اعتماد نظام «الكوتا» في انتخابات سنة 2002، مرورًا بالإصلاحات الدستورية والسياسية والقانونية لسنة 2011، لم تقد تلك الخطوات لتمكين سياسي حقيقي، بقدر ما أدت لإدخال سقف زجاجي جديد، يعيق أي إمكانية للترشح وللفوز خارج اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، الأمر الذي عكسته نتائج اللوائح المحلية التي تم التوقف عندها، فضلًا عن تحويل نظام «الكوتا» من آلية للتمكين السياسي والنهوض بالتمثيلية النسائية في البرلمان، لآلية لإعادة الإنتاج الاجتماعي وأداة لخدمة وتعزيز سياسات المحسوبية والريع الحزبي.