
بقلم: ياسين الحاج صالح
جهة النشر: الجمهورية al-Jumhuriya
أدخلت الثورة السورية الديمقراطيين السوريين، من ناشطين أفراد ومثقفين وشبكاتِ «مجتمع مدني» ومنظمات سياسية صغيرة، في أزمة عميقة لم يُستجب لها فكرياً ولو بالحد الأدنى. وهذا مَبْعث مفارقة كبيرة، تتمثّل في أن أكبر حضور للشعب في السياسة في مجتمعاتنا، بل أكبر ثورات اجتماعية سياسية في تاريخنا الحديث، تمخّضت عن أزمة في المجموعات التي تُعرّف نفسها بالديمقراطية (حكم الشعب)، وبالكتابة والتفكير في قضية الديمقراطية. الثورات العربية ديمقراطيةٌ جوهرياً من حيث أنها مسعىً شعبيٌ للتغيير السياسي، استهدف نمط ممارسة الحكم، ومرّ بامتلاك جمهور واسع بقدرٍ غير مسبوق للسياسة (التجمع والكلام في الشأن العام والاحتجاج)، فكيف حصلَ أن أفضت ثورات ديمقراطية إلى أزمة الديمقراطيين؟
لا يعود الأمر في السياق السوري إلى فشل الثورة، بل لعلّ فشل الثورة وأزمة الديمقراطيين يعودان معاً إلى عاقبة أساسية للثورة السورية، وبدرجات متفاوتة الثورات العربية الأخرى، أعني صعود الإسلاميين، بمن فيهم تشكيلاتٌ عدمية، جمعت بين مقاطعة العالم الحديث وتنظيماته وبين الوحشية في تعاملها مع السكان. وهو ما سهّل كسب نظامِ طغيانٍ للصراع ضد الجميع، وأدخل الجميع في أزمات وجودية. في سورية، بلغ الصراع من العنف أن البلد بالذات في أزمة وجودية. ستجري العودة إلى هذه النقاط، إلا أنه يلزم التنويه هنا أن هذه المناقشة تنطوي على نقد ذاتي وموضوعي إن جاز التعبير، نقد لمنظورات وحساسيات ظهرت بالتجربة محدوديتُها ونواقصُها، كما هو نقدٌ لأفكار وممارسات كانت ولا تزال تبدو لي قاصرة وعلى عداء مع الديمقراطية. هزيمة الثورة السورية أظهرت نواقصنا وأوجه قصورنا، ولا أرى بحال أنها تُظهر صواب أفكارٍ انتقدناها كديمقراطيين سوريين وخاصمناها. ستُذكر بعض هذه القضايا في سياق النقاش، بأمل أن تُتاح الفرصة لمناقشة مفصّلة لها يوماً. هذه المقالة تصرّ على صواب الموقع الأخلاقي والفكري للديمقراطيين السوريين وتفوّقه على أي منظورات أخرى. نتكلم على أزمة الديمقراطيين السوريين لأن تَفوُّقَ الموقع الأخلاقي والفكري لم يُترجَم إلى سياسة ديمقراطية مثمرة.
أي جماعة سياسية سورية؟
قد يمكن عزوُ فشل الديمقراطيين السياسي في سورية إلى جذر فكري سابق للثورة السورية، ويشمل المناضلين الديمقراطيين وغيرهم، وأعني غياب تصور مطابق للجماعة السياسية السورية. بقدر كبير، وُلدت الفكرة الديمقراطية في سبعينيات القرن العشرين في سورية في إطار تصور عروبي للذات، أخذ يُشحَن بمحتوى إسلامي في ثمانينيات القرن نفسه وبعد، على ما تشهد أعمال أبرز مثقف سوري تمحورَ تفكيره حول الديمقراطية، برهان غليون. تشهد عليه كذلك مؤتمرات كانت تعقد في ثمانينيات القرن العشرين، تجمع مثقفين عروبيين وإسلاميين، يتباحثون في واقع «الأمة» ومستقبلها، وتجمعهم فكرة الديمقراطية. وكان من أبرزهم إلى جانب غليون المرحوم محمد عابد الجابري، ومن مصر المرحوم طارق البِشري. ورغم أن المحتوى الإسلامي للذات في أعمال غليون هو إيجابية عامة حيال الميراث الإسلامي، وليس سياسةً إسلامية بحال، ولا تديناً إسلامياً كذلك، إلا أن تَصوَّر الذات هذا لا يوفر أساساً لسياسة ديمقراطية مميزة. ربما يوفر أساساً لسياسة قومية تحررية. شخّصَ غليون في كتابه المحنة العربية مشكلةَ العرب السياسية في الدولة المعادية للأمة. لكن تعريفه للأمة ثقافوي، يُحيل ضمناً إلى العروبة والإسلام، ويوفر فرص تماهٍ أكبر للعرب والمسلمين في هذا التعريف، وتماهٍ أقل لغيرهم. وأُقرّ بأني كنت شريكاً في هذا التصوّر حتى قبل الثورة السورية بعامين أو ثلاثة1، ولم أبلور تصوراً إيجابياً للذات حين بدأتُ آخذُ مسافة نقدية منه.
المشكلة في طرح الديمقراطية استناداً إلى مفهوم الأمة تتمثل في أنه يجنح إلى إقامة أكثريات دائمة وأقليات دائمة، على ما يمكن أن يستفاد من محمود ممداني في كتابه لا مستوطنون ولا أصلانيون: في تشكل الأقليات الدائمة وتداعيها 2، وهذا نقيض مقاصدِ الديمقراطية التي تتوافق مع أكثريات وأقليات متغيرة، بحيث يمكن لمن هم في الأقلية اليوم أن يكونوا في الأكثرية غداً، والعكس بالعكس. الفرصة أكبر لقوميين عرب أو إسلاميين أو مزيج منهما في أن يشكلوا أكثرية دائمة في سورية ديمقراطية. ولماذا الديمقراطية أصلاً ما دامت الأكثرية معروفة سلفاً؟ الواقع أن الحكم البعثي نشأ وهو يفكر بنفسه كتعبير عن إرادة الأمة العربية، وإنْ في قطر محدد، «القطر العربية السوري»، وكان التصور القومي العربي مهيمناً بالفعل إلى درجة أغنت عن شكليات مثل حرية التنظيم والتعدد السياسي والانتخابات الحرة وصناديق الاقتراع. وحين يعترض إسلاميون سنيّون على أن السنيّين ليسوا طائفة، وإنما هم الأمة، فإن هذه القضية جزءٌ معرفي من كلٍّ سياسي مُوجَّه نحو تسويق أنفسهم كقادة طبيعيين لهذه الأمة، مما لا يحتاج إلى تحكيمِ أي عمليات ومؤسسات ديمقراطية. الفرق أن أمة الإسلاميين إسلامية فيما أمة القوميين العرب عربية، لكن التحول الذي جرى من واحدة إلى الأخرى في ثمانينيات القرن العشرين يحيل إلى بنية مشتركة، ربما تكثِّفها فكرة «الرسالة الخالدة» وتصور إمبراطوري للذات والتاريخ. وفي ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته تحللت العروبة السورية إلى «سورية الأسد»، وعمادها أسرة جانحة وأجهزة مخابرات مختصة بالتعذيب، وإلى أسلمة متسعة للأوساط السنّية. لم يكد يَبقَ عربٌ في «قلب العروبة النابض».
مقابل طرح غليون، لم يكن ثمّة طرح ديمقراطي يقترح ذاتية سياسية مغايرة، سوريّة وقائمة على المواطنة، بل كان ثمّة تَشكك وعداء للديمقراطية باسم أولوية بناء الدولة مثلاً عند عزيز العظمة (وهو ما عمل المرحوم لؤي حسين على ترجمته إلى منظمة سياسية: تيار بناء الدولة)، أو باسم الخوف من طغيان الأكثرية الذي ستأتي به الديمقراطية على ما خشي المرحوم جورج طرابيشي (والعظمة كذلك). وعدا اللاتكافؤ السياسي والقيمي للطرحين، فليس ثمة تكافؤ بينهما على مستوى قابلية التطور. غليون هو من تناول في موسم «ربيع دمشق» القصير ما سماها في حينه أزمة الوطنية السورية، واقترح عقداً وطنياً جديداً يستوعب التعدد السوري، فيما تجمّد الطرح المعادي للديمقراطية على مقدماته النخبوية المتشائمة، ولم يستطع أن يُراجعها ولا أن يُضيف إليها شيئاً.
في «ربيع دمشق» كانت فكرة الوطنية السورية هي الركيزة الضمنية للتفكير والنشاط السياسي، وإن لم تكن موضوعَ نظر ونقاش كافيين. لم يجر اشتباك مباشر مع فكرة الجماعة السياسية السورية، ولا محاولة للتنظير في العلاقة بين الجماعة السياسية وبين كل من العروبة والإسلام. في سورية من هُم غير عرب من كُرد وأرمن وسريان وتركمان وشركس…، وفيها من هم غير مسلمين من مسيحيين وإيزيديين، وغير مسلمين سنيين من علويين ودروز وإسماعيليين وشيعة (وهم يتماهون أقل من السنيين بالتاريخ الإسلامي، والتاريخ العربي مثلما صاغه القوميون العرب في القرن العشرين)، وفيها بطبيعة الحال من لا يعرّفون أنفسهم بأيّ هويات موروثة. مفهوم الجماعة السياسية يشمل هؤلاء كلهم، ويشكل إطاراً للمساواة بينهم كمواطنين سوريين. هذا قلّما قيلَ بوضوح، وافتُرِض وفقاً لمنطق شائع أن الديمقراطية تحل التوترات المحتملة بين منحدرين من هذه الجماعات، وتُوفر إطاراً لتعايش الهويات المتعددة عند الفرد الواحد أو في المجتمع ككل. وبينما بدا أن الديمقراطية هي الفكرة المهيمنة على ما يشهد تأسيس «إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي» في خريف 2005، فإن الشغل الكتابي على الفكرة والشؤون السياسية السورية ظل محدوداً جداً، وتقريباً اقتصرت المساهمة فيه على بضعة أسماء، وأساساً من خلال مقالات في الصحف والمواقع الإلكترونية. كان غليون نفسه والمرحوم ميشيل كيلو من أبرزهم.
«إعلان دمشق» ذاته يشهد على شيء آخر: أن أياً من المعارضين السوريين على تباين خلفياتهم لم يجعل من التقارب السياسي مع الإسلاميين، وكان المقصود وقتها الإخوان تحديداً، مشكلة. يمكن القول إن المعارضة الديمقراطية السورية كانت وفيّة لفكرة تحالفات سياسية عابرة للإيديولوجيات ولتصوّرٍ استيعابي لسياسة ديمقراطية لا تستبعد الإسلاميين، وهم الذين كانوا قد تعرّضوا لقمع ساحق في ثمانينيات القرن، وكان الناجون منهم يعيشون خارج سورية منذ ربع قرن وقتها.
دخلنا الثورة السورية بهذا التصور الاستيعابي، «الوطني الديمقراطي»، للسياسة. كان لدى النظام تصور آخر للسياسة، استيعابي بطريقته الخاصة، يجمع بين «تحالف الأقليات» وبين تأليف قلوب نافذين في البيئات السنية المركزية، في دمشق بشكل خاص. العلاقة بين هذين الاستيعابَين علاقة استبعاد على مستوى الحساسية وعلى مستوى الأفكار. لكن حضور الأفكار كان محدوداً في الواقع بفعل قلة المشاركين في النقاش والشروط السياسية والأمنية للنقاش، وهي لا تسمح بتعبيرات حرة عن الرأي، ولا تُشجع أعداداً أكبر على المشاركة.
في المحصلة، لم يترافق تعمم الفكرة الديمقراطية في أوساط الطيف السوري المعارض بتعريف مطابق للذات السياسية السورية، يقوم على المواطنة، ويعمل على تحييد القومية والدين والطائفة. كانت لدينا فكرة ديمقراطية عائمة بعض الشيء. ثم تفجرت لدينا ثورة شعبية، ووجهت بالحرب، ولم تلبث دواعي الاستمرار أن ساقتها نحو التمفصّل مع ذات أو جماعة سياسية أخرى، الإسلامية السنّية التي تعرضت لبطش تمييزي من النظام، وليس الجماعة السياسية السورية المتصوَّرة إطاراً للديمقراطية والمواطنة. لكن بهذا الاستمرار انتقلت إلى ما دون السياسة، إلى الأهلي والديني. الديمقراطية لا تعمل على هذا المستوى. والديمقراطيون يتشتتون.
الطائفية
والمنبع الثاني لأزمة الديمقراطيين السوريين يتصل بالطائفية، وهي داء اتجه لأن يكون عضالاً ومُعنِّداً في الجسم السياسي السوري منذ ثمانينيات القرن العشرين وقبل. هنا أيضاً ثمّة مشكلة مطابَقة في التفكير السياسي. الطائفية إما أُنكرت كمشكلة كلياً، أو في أحسن الأحوال لم يجر نقاش مستقيم ومثمر بشأنها. وهنا أيضاً، تحُوْل الشروط السياسية للنقاش دون ظهوره بصور غير مواربة، وتُضيّق إلى أقصى حد دائرة المشاركين فيه. لكن الأمر يتعلق بتحدٍّ فكري وسياسي أساسي، لا تصون فكرة الديمقراطية كرامتها، بل شرعيتها ذاتها، دون الاستجابة النظرية والعملية له. لم يحدث هذا. الطائفيةُ التي لم نموضِعها، نجعل منها موضوعاً بالبحث والتحليل، مَوْضَعتنا هي، جعلت كثيرين منا حَمَلةً لها، متفرقين بتفرق حمولاتهم. وكان هذا التفرق ممّا أسهم في ضعف الطيف بمجمله وعزله اجتماعياً. ومن قد يُحسبون على طيف ديمقراطي سوري وقعت بينهم مخاصمات مسمومة تتصل بالموضوع الطائفي، وبصور مُعنِّدة هي الأخرى، تصمد للمقارنة مع أعتى نزاعات القبائل وأدوَمِها، لا حرب داحس والغبراء و«لا طل الخبر» بحسب تعبير شعبي شائع. وهو ما أسهم كذلك في توفير هامش مناورة واسع للنظام، أي زيادة حريته حيال الجميع.
تعرِض الطائفية تكويناً خاصاً في سورية، لا يشبه في شيء لبنان أو العراق حيث الطائفية رسمية ومُدسترة. يتمثل تكوينها السوري الخاص في تطييف ما أُسميه الدولة الباطنة، العائلة الأسدية والأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية ذات الوظيفة الأمنية، أي مفاصل القوة والإكراه في البلد، أو مراكز السلطة الفعلية. الدولة الظاهرة بالمقابل، من حكومة وإدارات و«سلطة تشريعية» وحزب حاكم وشرطة، وحتى جيش نظامي، هي عامّة وغير طائفية، لكن يسري في مراتبها الحكومية والتشريعية تحاصٌّ طائفي ضمني تشرف عليه الأجهزة الأمنية، أي مركز السلطة المُطيَّف. ولأن الأجهزة الأمنية السرّية هي منبع التطييف العام، فإن كل ما يتصل بالطائفية أمني وسري بدوره، «تابو» ممنوعٌ من النقاش العام، لكن ليس من الممارسة الفعلية للمستولين على السلطة. ونحصل على وضع غريب كان منيف الرزّاز، وهو من الرعيل البعثي الأول، أشار إليه منذ ستينيات القرن العشرين: من يمارسون الطائفية ويَسوْسون بها ضمناً لا يؤاخَذون على شيء، ومن يتكلم بها هو من يُؤاخذ ويُتّهم بالطائفية، ومن قبل ممارسيها بالذات. كان الصمت السياسي العام ثغرة هائلة، لعبت أكثر وأكثر لمصلحة الإسلاميين الأكثر تشدداً، الذين يمارسون الطائفية ويتكلمون عنها دون تحفظ. لماذا يمكن أن يستمع أيٌّ كان لمن ينكرون وقائع الطائفية أو يجمجمون بشأنها، حين هي واقعٌ معاشٌ بكثافة يخبره المُعرَّضون للتمييز يومياً؟ سيُستمع إلى من يقابلون الطائفية بالطائفية.
وخلال أكثر من نصف قرن بعد الرزاز، ترسّخت الطائفية في الوقائع والنفوس على نحو لا يجعل الدولة الوطنية مستحيلة، بل يجعل المجتمع مستحيلاً، والسياسة بالتالي. مقاطعة هذه البنية واقتراح سياسة أخرى لا تنبثق منها تبقى متروكة لخيالنا السياسي.
وسارت الطائفية مع خصخصة الدولة تدريجياً في الحقبة الأسدية، وهو ما تُرجم إلى واقع فعلي في التوريث عام 2000. خصخصة الدولة تعني نزع وطنيتها بطبيعة الحال، مثلما يعني التطييف تقسيمَ المجتمع وتقويضَ أسس قيام جماعة سياسية وطنية. لقد عشنا طوال عقود في ظل أزمة ثقة وطنية، عملت «الدولة» على مُفاقمتها لا على معالجتها، وهذا لأنها تجعل منها، أعني «الدولة»، مُطفئ الحرائق العام. جمعت بين العرب والكرد، خاصة في منطقة الجزيرة، مشاعر يتمازج فيها الخوف مع الكره؛ ومثلها تقريباً بين المسلمين والمسيحيين؛ ومثلها وأكثر بين عموم السنيين والعلويين؛ فصار النظام هو الحل لأزمة يحرص على تغذيتها واستحكامها. وهو ما سيَظهر بجلاء في انفجار هذا المجتمع المفخخ بالخوف والكره بعد الثورة.
ولعله يمكن إجمال ما جرى للسوريين في الحقبة الأسدية بأنه تقويض الديموس؛ جمعية المواطنين التي يمكن أن تكون إطاراً لمداولات ديمقراطية، وفي الوقت نفسه تقويض القراطوس؛ بنى الحكم التي تستجيب لمداولات الديموس وتعمل على عقلنة الحياة العامة. وبذلك انهارت البنية التحتية لأي ديمقراطية ممكنة.
من وجهة نظر النضال الديمقراطي، يبدو متعذراً جداً حل مشكلتَي الدولة منزوعة الوطنية والمجتمع المُطيّف والمنقسم، منزوع الوطنية بدوره بالتالي، والمحروم فوق ذلك من السياسة. التجربة بعد الثورة السورية أظهرت أن امتلاك السياسة قد يحدث عبر الدين، فتُترجم وقائع التطييف الاجتماعي إلى وقائع سياسية مباشرة. هذا وقع فعلاً. ما لم يقع هو نزعُ نزعِ وطنية الدولة، أو تأميمها. بالعكس، تَرجمت الدولة المخصخصة وطنيتها المنزوعة من تحت طائفياً إلى وطنية منزوعة من فوق بالاستعانة بقوى أجنبية ضد محكوميها الثائرين. وما لم يُقل هو أن المجتمع المطيَّف يشكل بيئة حرب جاهزة، وأن فرصتنا في تجنب الحرب الأهلية الطائفية محدودة دون نزع الطائفية المُطيِّفة إن جاز التعبير، أي طائفية الدولة.
وهكذا واجهنا انتقال الطائفية إلى واقع سياسي مسلح ومقاتل بعد الثورة، مع بقاء طائفية الدولة المسلحة والمقاتلة، فحصلنا على الأسوأ من المجتمع ومن الدولة معاً.
لم تكد تؤخذ هذه المعطيات بالاعتبار إلا على نطاق ضيق، ولم تتمفصل مع أي برامج سياسية كانت موجودة قبل الثورة أو مع أي وثائق سياسية صدرت بعدها. فلم يُقل شيءٌ عن وجوب تأميم الدولة، وعن ضرورة الحيلولة دون تطييف معاكس، وعن وجوب تجريم الحكم الأبدي والتوريث. أي لم يجر مَفْصلة المقترحات الدستورية المحتملة مع وقائع الدولة والسياسة والمؤسسات في سورية طوال أكثر من نصف قرن.
سورية في بداية الثورة لم تكن دكتاتورية وطنية مثل إسبانيا تحت سلطة فرانكو حتى منتصف سبعينيات القرن الماضي، أو مثل كوريا الجنوبية قبل نهاية الدكتاتورية بعد إسبانيا بنحو عقد، وقد يكون أقرب نموذج عربي إليهما تونس أيام بورقيبة. سورية في الحقبة الأسدية دولة طغيان سلطاني وراثي، ذي منازعَ إبادية، وليست بحال نظاماً دكتاتورياً. وبينما لا تحوز الدعوة إلى دكتاتورية وطنية، أي التفويض بحكم عسكري لبضع سنوات بغرض تحطيم الزُمر العسكرية الدينية والطائفية والجهوية، وإلغاء التنظيمات السلطانية بما فيها أجهزة المخابرات الطائفية، وتوحيد البلد وحصر السلاح بيد الدولة، لا تحوز أي فرصة في الواقع، فإنها قبل ذلك لا تكاد تكون مفهومة. في صيف 2013، وتحت حرارة التجربة في دوما والرقة، كتبتُ جملة واحدة على صفحتي على فيسبوك تتكلم عن حاجة سورية إلى دكتاتورية وطنية، فووْجه ذلك بعتاب ودّي وتسفيه عدائي في آن. هل يدعو ديمقراطي إلى دكتاتورية وطنية؟ لا يجب أن يكون ذلك ممتنعاً. المسألة مسألة شروط عينية، وليس تحكيمَ مبادئ مجردة.
ودون تجاوز دكتاتوري للسلطانية المحدثة3، يبقى تجاوزٌ واحد: «ديمقراطية توافقية»، أي نظام تحاص طائفي مدسْتر، مثلما نعرفه في لبنان والعراق. وهذا نظام أزمة دائمة، ومفتوح على تبعيات خارجية متنوعة مثلما نعرف في البلدين الجارين.
جينوسايد؟
ويعود جانب ثالث من أزمة الديمقراطيين والطرح الديمقراطي إلى هذا التقاطع المميت بين الطائفية والطغيان، وما ينفتح عليه ذلك من تعريف للخصم السياسي.
يجري الكلام عموماً على نظام استبدادي، وأحياناً على نظام قمعي ودكتاتوري. وهذا بين عائم وغير صحيح، بل إن الكلام على دكتاتورية يُخفق في رؤية النزع الشامل لوطنية الدولة والمجتمع عبر التحول السلطاني والتطييف المديد، ويُخفق من ثم في فهم أسباب الدمار السوري. الدكتاتورية لا تؤدي إلى دمار واسع هائل كهذا. وعبارة الاستبداد أشد عمومية من أن تنفع في التحليل.
يتجاوز الأمر أن طائفية الدولة وتطييف المجتمع يُضعِف إلى أقصى حد فرص ظهور قوى ديمقراطية، إلى أن الدولة المخصخصة والمطيّفة تكون منزوعة الوطنية كما تقدم، أي أشبه بوكالة احتلال أجنبي أو قوة استعمارية، وهو ما تُرجم إلى واقع سياسي مباشر فعلاً بالدعم الإيراني للنظام منذ البداية، ثم التدخل الروسي بطلب إيراني أسدي، فيما لم يُعرض على الثائرين في أي وقت حل سياسي يقود إلى تغيير ذي معنى في البيئة السياسية السورية. ثم إنه ما إن نتكلم على طائفية الدولة حتى نتكلم على احتمال الإبادة أو الجينوسايد كشكل محتمل للصراع السياسي. وهو ما تحقق بدوره بعد الثورة 2011، وتلامحت إمكانياته منذ موجة الصراع الأبكر بين أواخر السبعينيات ومطالع الثمانينيات. الديمقراطية يمكن أن تكون شعار تعبئة وبرنامجاً سياسياً في مواجهة نظام قمعي دكتاتوري في إطار بنية وطنية، ولكنها لا تكاد تعني شيئاً في شروط الإبادة والحماية الخارجية، ولا تملك ما تقوله في مثل هذه الشروط. فإذا كان قتل مئات ألوف البشر وتهجير الملايين واستخدام أسلحة الدمار الشامل منهجَ حكمٍ ممكناً، فليس من حل غير تدخل من خارج الإطار يحمي الضحايا ويعاقب المجرمين. ليس هناك نظام جينوسايد سقط بفعل نضال الديمقراطيين المحليين.
والحال أننا حصلنا بالفعل على تدخلات خارجية كثيرة بدل تدخل واحد، جمعها تشخيص الإرهاب بوصفه الشرّ السياسي الأساسي، وليس الجينوسايد، فلم يمرّ الأخير دون عواقب فقط، وإنما مع مكافأة ضمنية للنظام القاتل الذي صار شريكاً في هذه الحرب ضد الإرهاب. لا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا ليبرالية تنفع في مثل هذه الشروط، لا شيء ينفع، ولا حتى سياسة الأعماق الدينية، التي لا يعدو أثرها تعميم الشرط الجينوسايدي. وهو ما حصل فعلاً على يد المجموعات السلفية السنّية.
هناك نقاش مشروع، وضروري في واقع الأمر، حول صلاحية مفهوم الجينوسايد (الإبادة على الهوية)، لوصف الصراع السوري بعد الثورة، وبخاصة من جهة أن الأمر يتعلق بـ«حرب»، يحدث أن توصف بأنها أهلية، أي أن من يقتلون ليسوا «ضحايا أبرياء»، مثلما هو مقرّر في مفهوم الجينوسايد بأثر المثال النموذجي الذي صيغ المفهوم لتمثيله، الهولوكوست. يتعلق الأمر بمحاربين يقاتلون، ومن يقاتلون يُقتلون. لكن هذا وجيه بقدر محدود فحسب. طوال الوقت احتكر النظام الطيران وأسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى، وموارد الدولة العامة. وهذا يسوّغ الكلام على حرب تعذيبية، شيء يقارب استهداف إسرائيل لغزة. هل هناك من يتكلم جاداً على «حرب» بين إسرائيل وحماس؟ الحرب التعذيبية هي تعذيب أكثر بكثير مما هي حرب، وضحاياها أقرب إلى «البريئين» منهم إلى محاربين4.
على أن صلاحية مفهوم الجينوسايد تبقى موضوع نقاش حتى لو أقررنا بفكرة الحرب التعذيبية، وبأن أكثرية الضحايا سقطوا على يد الدولة، وأنهم استُهدفوا تمييزياً لحيثيتهم السنّية، مما هو محقَّق بالفعل. فأكثرية ساحقة من الضحايا، ربما 90 بالمئة منهم سقطوا على يد «الدولة» فعلاً، وبيئات سنّية هي وحدها دون غيرها استُهدفت بالمجازر الكبيرة والصغيرة، ومنها الكيماوية، والقصف بالبراميل المتفجرة، وجميع من قتلوا بالتعذيب وتحت التعذيب تقريباً. لا يتعلق الأمر حتماً بِنيّة مُبيَّتة، مثلما يقرر ميثاق الأمم المتحدة الخاص بمنع ومعاقبة الجينوسايد، لكن للبنية السلطانية المهجوسة بالسيادة والأبد «نيّتُـ»ها، أو منطقها الترجيحي، الذي يُخفض عتبة استهداف البعض ويسهله، ويرفع عتبة استهداف آخرين ويصعبه.
ولا يضاد هذه المساجلة الوجيزة القول إنه جرى استهداف مدنيين علويين من تشكيلات مسلحة سنّية، وأن هذه أيضاً مجازر جينوسايدية. إنها بلا شك كذلك، وما فعله جيش الإسلام في عدرا العمالية5 في الشهر الأخير من 2013، أو جبهة النصرة في أرياف شمال اللاذقية، هو بالضبط مجازر جينوسايدية. ليس الغرض هنا بحال نفي الاستعداد الإبادي عن أي جماعات خارج النظام، الغرض بالأحرى تأصيل الإبادة في البنى الطائفية، أو رؤية الطاقة الجينوسايدية في التشكيلات الطائفية، سواء كانت حاكمة أم محكومة6.
هذا ليس لإغلاق النقاش حول الجينوسايد، فالمفهوم إشكاليٌ لأنه يفترض هويات مُعطاة سلفاً، سابقة للصراع، وليس تشكلها ذاته أحدَ أوجه الصراع. ثم لأنه يغلب أن يتوافق مع حلول هوياتية للصراعات الإبادية. أستخدمه أداتياً هنا لأنه يساعد في إضاءة جوانب مهمة من صراعنا، بانتظار تطوير مفاهيم وأدوات تحليل أفضل.
على أي حال، حين تكون الحياة مستباحة إلى هذه الحدود الإبادية، فإن الكلام على الديمقراطية يصير غير ذي معنى.
أسلمة الثورة
ويتصل منبع رابع لأزمة الديمقراطيين السوريين بما تقدمت الإشارة إليه من صعود الإسلاميين على أكتاف ثورة أوسع طيفاً عند انطلاقها. لم يكن مسار الصعود على نحو ما شهدناه مذهولين عامي 2012 و2013 خطياً وحتمياً، ويُحيلنا تقصّي جذروه على تاريخ سورية خلال الحقبة الأسدية، وتاريخ الشرق الأوسط خلال العقود السابقة للثورات. لكن ذلك الصعود أخذ شكلاً منفراً إلى أقصى حد، يتجاوز أسوأ ما تخيّله أي ديمقراطيين سوريين، والأرجح أنه كذلك أسوأ مما تخيّله المحذرون من طغيان الأكثرية بالذات. الواقع أنه كان طغياناً فاشياً لأقليات أكثروية، طغت رمزياته ولُغته في الثورة السورية منذ عام 2013، وأَدخلَ غير الإسلاميين من الثائرين السوريين والمنحازين للثورة في أزمة فكرية وسياسية وأخلاقية عميقة. بل لقد بدا أنه يصادق على ما كان يقوله من كنّا ننتقدهم قبل الثورات من علمانيين تسلّطيين تتلّخص دعواهم في أن الدولة هي الحل، ومن ثقافويين علمانيين تتلّخص دعواهم في أن رؤوس عموم الناس هي المشكلة. ولم نستطع بغير مشقة كبيرة خلال السنوات المنقضية شقَّ درب يجمع بين اعتراض مبدئي على السلطانية المحدثة التي طوّرت منازع إبادية تجعل الكلام على الدكتاتورية والقمع متقادماً وغير ذي موضوع، وبين اعتراض سياسي وأخلاقي متّسق على الإسلامية التي طوّرت منازع فاشية بسرعة قياسية. وبعد أن كنا نناضل من أجل الحريات السياسية وحكم القانون، وجدنا المناطق التي يسيطر عليها الإسلاميون تفتقر إلى الحريات الاجتماعية: ما يتصل بكيف تأكل وتشرب وتلبس وتظهر في الشارع، وتُستباح حياة الناس وأملاكهم باسم الشريعة. عنف النظام الإبادي عزّز الإسلامية المسلحة التي لديها جواب على هذا العنف هو العنف المضاد. بالمقابل، حال هذا العنف بأشكاله البدائية وخطابه مفرط الطائفية دون أن تتآكل قاعدة النظام الاجتماعية، بل وأسهم في أن تتعزز بعد 2013 رغم المذابح الكيماوية والبراميل. والمقياس الأمين لذلك هو توقف ظاهرة الانشقاقات التي أوهنت النظام بالفعل خلال عامي الثورة الأولين، وإن لم تكد تمس الدولة الباطنة، المُطيّفة.
نحن في أزمة بسبب هذا العسر. حدث تنافر انفعالي خلال وقت قياسي بين الانفعالات الغاضبة المضادة لنظام دموي تمييزي وبين الانفعالات المُخْجلة التي تثيرها أسلمة مسلحة بالغة الرجعية، فكان صعباً الاستجابة المرنة لهذا التنافر على مستوى الانفعال، وليس سهلاً على مستوى الأفكار.
وفي الحيثية الخاصة بصعود الإسلاميين، يتجاوز الأمر سورية إلى مصر، وبصورة مختلفة ليبيا واليمن، وبصورة مختلفة أيضاً تونس. في مصر انتفضت قطاعات شعبية واسعة ضد حكم الإخوان ومساعي أخونة الدولة. انقلاب السيسي جاء على كتف هذه الانتفاضة، ووضع الديمقراطيين المصريين في أزمة وتخبط، يجد المرء مثالاً صادقاً عليها في كتاب علاء عبد الفتاح: شبح الربيع7(2022). في تونس لا يبدو أن حزب النهضة عمل على أخونة الدولة، لكنه مع ذلك أثار نفور قطاعات مهمة من المجتمع التونسي، من النساء ومهنيي الطبقة الوسطى المدينيين وعموم المثقفين والإعلاميين. لقد بدا كل ذلك بمثابة تزكية لنُظُم الطغيان الدولتي التي شبّت الثورات ضدها. وبينهما، لم يبدُ أن الديمقراطيين ينتفعون بشيء من مشكلات هؤلاء وأولئك. نحن في أزمة لذلك.
تختلف سورية عن البلدان العربية التي ذُكرت للتو في تمفصلٍ مضاعف للإسلامية إن جاز التعبير: تمفصلها مثلما في البلدان الأخرى مع الإفقار السياسي الجائر للسكان، وقيام الدين بدورِ حدٍّ لهذا الفقر السياسي، يوفر «رأياً» يستحيل قمعه هو النصوص المقدسة، و«تجمُّعاً» يستحيل فضّه هو تجمع المصلين في المساجد، ثم تمفصلها مع الحيثية الطائفية للحكم الأسدي الذي يتناسب ارتكازه على الجماعة العلوية طرداً مع طغيانه السلطاني وإرادة البقاء في الحكم «إلى الأبد». ليس الحكم الأسدي طغيانياً سلطانياً لأنه علوي على ما قد يُفضّل الإسلاميون الاعتقاد، بل بالعكس تماماً، طوّر بعده الطائفي العلوي لأنه طغياني. أياً يكن الأمر، تستمد الإسلامية السنّية السورية طاقتها الانفعالية والتحريضية من وقائع التمييز الطائفية المرسخة، وليس فقط الإفقار السياسي الشديد.
ثم كذلك من وَهْم أن السنيين هُم الأمة، وأن الأمر يتعلق بإعادة الأمور إلى نصاب صحيح لها بعد انحراف عارض، طال به الأمد. هذا الصلف السنّي باطل. إذ تفتقر المجموعات السنّية المسلحة إلى الهيمنة، الفكرة القوية المقنعة التي من شأنها أن تجتذب جمهوراً أوسع، وربما بعض غير السنيين، فتجعل منها شيئاً آخر غير طائفة. الإيمان الديني بحد ذاته ليس تلك الفكرة لأنه لا يقتضي تشكيلات دينية سياسية بعينها، ثم لأنه لا يُلزِم غير المؤمنين. ومقياس الافتقار إلى الهيمنة والقوة الإقناعية الرضائية هو اللجوء الواسع إلى العنف من قبل المجموعات الإسلامية، مع ما هو معلوم من تنازعها فيها بينها وتحاربها. فإذا كانت الهيمنة هي ما يجعل من جماعة صغيرة أمة أو نواة أمة، فإن غياب الهيمنة هو ما يحوّل جماعة كبيرة إلى طائفة، مجموعة منكمشة، تميُّزها حساسية ولغة خاصتين، لكنها بلا أفق عام. «القوم السنّي»، الأكثري، الذي أمل ياسين الحافظ تحديث وعقلنة وعيه في سبعينيات القرن العشرين، سار بتأثير الهزائم والنكبات والعنجهية في اتجاه معاكس.
والواقع أنه إذا كان ثمّة جماعة سورية كانت قريبة من أن تكون الأمة أو ركيزة لها، فهي العلويون السوريون بالذات. وذلك بفعل هيمنة محققة في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته على الأقل، تقاطعت في تحققها القومية العربية الجامعة المتطلعة خطابياً على الأقل إلى تجاوز الانقسامات الأهلية، مع نزعة يسارية مساواتية تخاطب شرائح اجتماعية متسعة في الأرياف وأطراف المدن، ومع قدر مميز من ليبرالية اجتماعية في قضايا المأكل والملبس والاختلاط بين الجنسين والسلوك في الحياة اليومية، ومع صعود ثقافي مميز لجماعة كانت فيما قبل مهمّشة فليس لديها امتيازات تدافع عنها (خلافاً لما هو الحال اليوم)، وبالعكس يميل كثير من المنحدرين منها إلى اعتناق أفكار تقدمية وتحررية صاعدة عالمياً، وفوق هذا كله موقع قوي في الدولة التي لم تكن مخصخصة بهذا القدر. حدَّ من هذه الهيمنة بقوة، فأتى عليها بدءاً من ثمانينيات القرن الماضي، التكوينُ الاستئثاري والتمييزي للنظام، وشخصية حافظ الأسد الحقود والثأرية، ثم تطوُّر نزعاتٍ محافظة في الأوساط العلوية بفعل امتيازاتٍ سياسية ومادية ومعنوية طوال أكثر من جيلين8. ولهذا انعكاساته الفكرية التبريرية والمعادية للديمقراطية.
فكان أن حصلنا على وضع بلا دولة ولا أمة، ولا ركيزة في المجتمع لأي منهما. الإسلاميون بديل وهمي في شروط انعدام البديل، وليس الديمقراطيون الذين تقمعهم الدولة المخصخصة ويشتتهم المجتمع المُطيّف. نعرّف أنفسنا كديمقراطيين بدلالة مناهضة السلطة المضادة للحرية والعدالة، وذات الحضور العدواني، المباشر واليومي في حياة الناس، وقد كانت طوال عقود سلطة الدولة. لكن بينما نفعل ذلك نجدنا مباشرة متجاوَزين من قبل من يعارضون هذه السلطة مستندين إلى لغة ورمزيات مألوفة أكثر، مع استعداد للقتال بعد الثورات افتقرَ إليه الديمقراطيون، ولم يُسائلوا هذا الافتقار عن وجاهته، كأنه من البديهي ألّا يكون الديمقراطيون مسلحين، ألّا يقاتلوا ولو دفاعاً عن النفس.
تُرى، هل إننا بتسليط الضوء على تكوين الإسلامية الطائفي والاستبعادي نعود إلى مواقف عبّر عنها علمانيون تسلّطيون (الدولة هي الحل) وثقافويون علمانيون (رؤوس العموم هي المشكلة) قبل الثورات؟ ولا بحال من الأحوال. فنحن ننطلق من تراكم تجارب هائل، قبل الثورة وأثناءها واليوم، يضعنا في موقع سياسي وأخلاقي لا يستطيع الإسلاميون أو غيرهم المزايدة عليه، موقع يفتقر العلمانيون التسلّطيون والثقافَويون العلمانيون إلى مثله. لقد كان الديمقراطيون السوريون إيجابيين حيال حق الإسلاميين في العدالة والعمل العام حين كان الإسلاميون في ضيم، مهمشين ومسحوقين، وفي أوساط الديمقراطيين دون غيرهم ظهرت التعبيرات الأكثر نقدية للإسلامية حين صار الإسلاميون سلطة أو سلطات في 2013 وما بعد، واستناداً إلى تراث كفاحي ومشاركة فعلية في النضال ضد الحكم الأسدي طوال تاريخه. وراءنا سجلٌ متّسق قيمياً من الصراع من أجل الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية، هو سندنا في النضال والنقد.
الديمقراطية في أزمة
ويتصل بمنبع خامس، دولي، لأزمة الديمقراطيين السوريين والعرب: أزمة عالمية في الديمقراطية، وضعف في الاستعداد القتالي دفاعاً عن الحرية وسيادة القانون (خلافاً لحال دوائر اليمين القومي والحضاري الغربي)، ومناخات فكرية قيمية تطلب منك أن تكون ضحية لا أن تكون مقاتلاً، كي «تتضامن» معك. سياسات التضامن هي إعادة إنتاج للضحايا، وعلاقات عدم التساوي بين المتضامنين والمتضامَن معهم.
ليس هناك، عالمياً اليوم، قوة دفع باتجاه الديمقراطية، وتجد التحركات الشعبية هنا وهناك نفسها معزولةً وبلا سند. بالعكس، يعرض عالم اليوم حالة من اللابديل، أي كذلك فقدان الوجهة والاستمرار السلبي لما هو قائم. دون بديل يعني دون مستقبل، يعني كذلك أننا نعيش عالمياً في حاضر مؤبد مثل «سورية الأسد»، أي في سجن زماني. وهذا يمكن أن يكون أخطر من السجون المكانية لأنه يحبس العالم ككل مع كونه، في الوقت نفسه، محسوساً أقل، ثم لأن شرط السجن الزماني لا يُبقي غير باب الرجوع باتجاهات قومية وحضارية ومعادية للديمقراطية مفتوحاً.
وتتعزز أهمية هذا العنصر المتصل بأزمة الديمقراطية في الغرب وفي العالم بعنصر آخر، هو ما وفّر سنداً لنظام إبادي في سورية، أعني أمننة السياسة عالمياً، بأثر متضافر من «الحرب ضد الإرهاب» ومن صعود سياسات الحدود ومنظمات اليمين الحضاري والقومي. تضع سياسة متمركزة حول الأمن أجهزة الأمن، وهي أجهزة القتل لدينا، كشركاء لشاغلي المواقع العليا في العالم، ويجري تعريف الشر السياسي الأساسي بأنه الإرهاب الذي يبدو أنه ينبع من تكوين الإرهابيين المفترضين، وليس من علاقات السلطة والثروة والمعلومات الدولية. لا الاستعمار ولا الاستعمار الاستيطاني، ولا العنصرية ونظام التمييز العنصري، ولا الحرب العدوانية وغزو بلدان أخرى، لا تدمير البيئة ولا بالطبع الليبرالية الجديدة، ولا الجينوسايد، هي الشر السياسي. الشر هو الإرهاب، أي ما يستهدف الأقوياء، الدوليين والمحليين. هذا وفّر أرضية تأهيل واقعية للحكم الأسدي منذ عام 2013، وإن دون مودة. عنصر المودة الضعيف في العلاقة مع النظام، هو أضعف بعد في العلاقة مع السوريين الثائرين الذين وصفهم باستهانة أوباما بمزارعين وأطباء أسنان، فيما فكرت أجهزة إدارته فيهم كإرهابيين، أو كمجموعات غير موثوقة في أحسن الأحوال.
الحكم الأسدي تحول منذ 2013 إلى شريك في الحرب ضد الإرهاب لأن هذا ما يتيح له قتل محكوميه ويرفع عنه الحرج الدولي. بعد يومين أو ثلاثة من زلزال 6 شباط (فبراير) الذي أودى بحياة فوق 7000 سوري، زايد فيصل المقداد وزير خارجية النظام على الأوربيين والأميركيين بأنهم إن كانوا جادين في محاربة الإرهاب، فيجب أن يرفعوا العقوبات عن النظام وأن تمر المساعدات الإنسانية عبره. النظام الذي كان يطالب بمؤتمر دولي لتعريف الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي، صار هو المحارب الحقيقي ضد الإرهاب اليوم.
والإرهاب المعني هو إرهاب منظمات إسلامية سنّية تحديداً، إلى درجة السكوت على منظمات لا تزال على قوائم الإرهاب الأميركية مثل حزب الله وحزب العمال الكردستاني، وكلاهما ضالع في حربنا السورية، واحد إلى جانب النظام وواحد ليس ضد النظام. والأصل في تحديد الإرهاب بتنويعته السنّية هو جناية القاعدة في الولايات المتحدة في 11 أيلول بخاصة، وعمليات قام بها قاعديون ودواعش في بلدان الغرب، استهدفت نسقياً المدنيين وحياة الناس العادية. هذا بالفعل إرهاب إجرامي مُستحِّقٌ لأشد الإدانة. لكن هذه الفئة من الإرهاب لم تَصِر كل الإرهاب فقط، وإنما كذلك صار الإرهاب يُشتق من العقيدة الدينية التي يرفع رايتها هؤلاء الإرهابيون. ولأن سبب الإرهاب هو الإرهابيون ودينهم، فلا حق لهم في العدالة ولا في السياسة، ويعاملون كمقاتلين غير شرعيين، لا معتقلين سياسيين ولا أسرى حرب. وبما أن هذا الإرهاب يصدر عن العنوان العقدي ذاته لأكثرية جمهور الثورة السورية، ونجح بقدر لا بأس به في الانتشار في البيئات السنّية المعارضة للنظام بعد 2012، فستخسر الثورة السورية قضيتها، وغاية ما قد يُعترف به هو المحنة الإنسانية للسوريين.
بالمقابل، ستكون الحرب ضد الإرهاب البيئة الأمثل لحياة نظام قتلٍ مثل الحكم الأسدي، لأنها حرب تعذيبية جوهرياً، ولأنها تشرعن التعذيب، ولأنها تعيد تعريف الدول لتصير أقرب إلى احتكارات للحرب المشروعة ضد الإرهاب (الإسلامي السنّي). ما كان يريده النظام يريده العالم كذلك، أليس هذا أفضل العوالم الممكنة إذن؟ قُل الإرهاب وانصب المشانق! قُل الإرهاب واقصف بالسارين! قُل الإرهاب ودمر بالبراميل!
الحرب ضد الإرهاب وأمننةُ السياسة مضادان للديمقراطية في كل مكان، بما في ذلك في دول الغرب نفسها، لأنهما يعززان الأجهزة السرّية والمكونات السرّية للسياسة، ويقويّان من هم أقوياء سلفاً من دول ونخب، ويُضعفان الضعفاء سلفاً من ثورات وحركات شعبية ومنظمات اجتماعية، ولأنهما يتوافقان مع حالة استثناء عالمية تطلق يد الأقوياء في مصائر المجتمعات.
لقد صار العالم أشبه بـ«سورية الأسد» في زمن الحرب ضد الإرهاب. هذا هو الشرط الدولي البنيوي للملاءمة الجذرية لهذه الحرب للنظام. ملاءمة مضاعفة، ينبغي القول، إذ علاوةً على الشبه، كانت الحرب ضد الإرهاب هي النقاب الأنسب على وجه الإبادة.
في ديمقراطية ولا ديمقراطية الديمقراطيين
كان مما أسهم في تشتيت الطيف الفكري السياسي الحديث في سورية في نصف القرن الأسدي، انقسامُهُ إلى خائفين من الديمقراطية أو معادين لها، يصفون دعاتها بالشعبوية ودعوتهم بالديمقراطوية؛ وإلى منحازين للديمقراطية، لكن دون ممارسات ديمقراطية مميزة، أو حتى بميول استبدادية، على ما عرض برهان غليون في كتابه عطب الذات9. هذه النقطة مهمة ليس لأن فُرص الديمقراطية مرهونة حتماً بسلوك ديمقراطي وشخصيات ديمقراطية، ولكن لأن وجود أشخاص «ديمقراطيين» هو حظٌ طيب في مجتمع في أزمة مركبة كمجتمعنا. قلّما كان حظنا طيباً في واقع الأمر.
على أنه لا ينبغي المبالغة كثيراً في أهمية ديمقراطية الأشخاص، لأن المهم في الديمقراطية هو وجود حياة سياسية تعددية قائمة على المداولات المفتوحة والحرة، هي ما تدفع الأفراد والمجموعات إلى التطبُّع الديمقراطي. الديمقراطية مسألة تعلّم وتدرّب، وهي ليست نتاج وجود مسبق لديمقراطيين. الضروري هو وجود منظمات تدعو إلى الديمقراطية وتعمل من أجل حياة سياسية تعددية. أما وجود شخصيات ديمقراطية وذات صفات قيادية فهو توفيق من المقادير.
نتكلم على أزمة الديمقراطيين في سورية، وليس على غيرهم، لأن الأمر يتعلق بقوة حياة تعثرت كثيراً. أما الموتى فلا يعانون من أي أزمات.
في السنوات الاثنتي عشرة المنقضية تبدو كلمة الثورة وقد حلّت محل الديمقراطية. فهل في ذلك ما يشير إلى تكافؤهما الانفعالي، أو إشباعهما معاً انفعالاً عدائياً موجهاً ضد النظام، ما يعني، إن صح، افتقار الدعوة الديمقراطية إلى محتوى إيجابي؟ دون الاستهانة بحدّة الانفعالات السلبية التي أثارها الحكم الأسدي في قلوب ما لا يحصى من سوريين تعرضوا للإهانات المباشرة والتعذيب وضروب متنوعة من الإيذاء، ودون التقليل من شأن الانفعالات في التعبئة السياسية (التحريض وتسعير «الحقد الطبقي» مهمات أساسية في الحزب اللينيني) وفي تحديد مضمون الدعوات السياسية بالذات، فقد ساعدت الفكرة الديمقراطية دون غيرها في تسليط الضوء على نمط ممارسة السلطة في البلد، وعلى تدهور الحياة العامة وتحلل الرابطة الوطنية، وعلى الطائفية وأزمة الوطنية والمواطنة. ليس صحيحاً بحال أن الديمقراطية كانت مجرد تعبير سلبي عن رفض النظام. ولا الثورة. بل حفزتهما معاً تطلعات محقة نحو أوضاع أكثر حرية وعدالة.
ربما صارت إشكالية الديمقراطية، على نحو ما أخذت تهيمن في أوساط مثقفين وناشطين سياسيين، مُتجاوَزَة اليوم، وذلك بأثر متضافر من فشل الثورة السورية والأزمة الوجودية للكيان والمجتمع السوريين، ومن أزمة الديمقراطية في العالم. فلا ينبغي أن تكون غاية جهدنا الوفاء لما اعتنقنا من منظورات فكرية سياسية قبل الثورة، والبقاء هناك. فشلت تلك المنظورات في الامتحان العسير، حتى أنها لم تستطع الدفاع عن نفسها. ما لم يفشل هو الروح الديمقراطية، المتطلعة إلى مجتمع أناس أحرار ومتساوين، والمنحازة بخاصة إلى الفئات والشرائح الأشد بؤسأ وحرماناً من السوريين، وهم اليوم أكثريتهم الساحقة. هذه الروح يمكن أن تندرج في تراكيب فكرية سياسية مختلفة، على نحو ما كانت الديمقراطية اندرجت يوماً في الفكر والمنظمات الاشتراكية10.
ولعل الشتات السوري في وضع أنسبَ للمشاركة من موقعٍ فاعلٍ في النقاش العالمي حول راهن العالم ومستقبله. إن صح ذلك فسيكون تشتتنا ضرباً من «مكر التاريخ»، قد يُغير نسق تفاعلنا مع العالم الحديث لأول مرة منذ ما قبل نشوء الكيان السوري ذاته.
أزمة وجودية
والخلاصة أنه تواطأ قصورٌ جوهري في التفكير الديمقراطي في سورية مع شروط سياسية بالغة القسوة، تتعزز فيها الاستعدادات الإبادية لنظام قائم جوهرياً على التمييز الطائفي مع نظام دولي داعم بنيوياً للإبادة، وإن لم يكن مسانداً سياسياً لها، ومع أوضاع عالمية مُضعِفة للديمقراطية ومُلائِمة لدول الإبادة وللتشكّلات القومية والدينية، ومع أوجه من قلة الحظ.
هذا بالطبع يضع أي «وطنيين ديمقراطيين» سوريين في أوضاع بالغة العسر، تتحدى معناهم وبقاءَهم ذاته. لقد كنا طوال عقود في مشقة ونكد، من رضي منا بالحكم الأسدي، لم يرض هذا به إلا تابعاً بلا حدٍّ أدنى من الاستقلال والاعتبار. وإذ نسعى وراء طيف أوسع من أجل التغيير، يحفزنا تصور استيعابي للسياسة والدولة، قائمٌ على شراكة مديدة في الاستبعاد مع الإسلاميين، نجد هؤلاء يعملون من أجل نظام استبعاد جديد، يريد السيادة لا السياسة، والدولة العامة لا الحزب الخاص.
الوضع العضال لسورية اليوم يتجاوز أن يكون أزمةً للديمقراطيين إلى انهيار وطني واجتماعي وإنساني شامل، مفتوح على الكارثة، يتجاوز قدرات السوريين كلهم. سورية ذاتها في أزمة وجودية قد لا تنجو منها. وبقدر ما إن سورية هي إطار النضال الديمقراطي، فإن أزمة هذا النضال وجه من أوجه أَزمتها المستحكمة.
على أن هناك دوماً ما يمكن عمله حين يبدو أنه لا يمكن عمل أي شيء: فإذا لم نستطع تحقيق تقدم في التمثيل السياسي للسوريين، فلا شيء يمنع محاولة تمثيل سورية وصراعاتنا الاجتماعية والسياسية فكرياً. والعمل على بلورة تصوّر مطابق للجماعة السياسة السورية، وما يعترض هذا التصوّر من مشكلات (العلاقة مع العروبة، ومع الإسلام)، يمكن أن يكون ركيزة مهمة لتجدد التفكير السياسي اليوم. ولما كان التكوين الجينوسايدي للنظام هو المصدر الثاني لدخول الفكرة الديمقراطية «في الحيط»، فإن الاهتمام بأدبيات الإبادة وقضايا العنف السياسي عموماً مجالٌ أساسيٌ للمعرفة والنقاش في النطاق السوري. وبقدر ما إن الجينوسايد في سورية مؤسَّس على تمثيلٍ سياسي بالغ الاختلال للمجتمع السوري، فإن من شأن تصوّر جماعة سياسية سورية مطابقة أن يمهد على مستوى الأفكار لسورية دون إبادة. إلى ذلك، فإن العالم جزء لا يتجزأ من سورية، ما يقضي بأن نعتني بفهم أحوال عالم اليوم، أن نكون جزءاً من النقاش العالمي حول الحاضر والمستقبل، وأن نربط بين التغيير في بلدنا وفي عالم متأزم كل يوم أكثر من سابقه. سورية ليست عالماً مصغراً لمجرد أن كثيراً من العالم في سورية (إسرائيل وإيران وأميركا وروسيا وتركيا، والجهادية السنية المعلومة والجهادية الشيعية الأقل عولمة لكن المنضبطة بمركز سياسي في طهران)، وكثير من السوريين في العالم (نحو 30 بالمئة منتشرون في 126 بلداً)، بل لأن عالم اليوم بلا بدائل، أي بلا مستقبل، أي لأنه أسير حاضر أبدي مثل سورية. وباختصار: لأنه سورية مُكبَّرة.
التقدم في معركة الأفكار لا يضمن حسم معركة الوقائع، لكن إن كان للأخيرة أن تُكسَب يوماً، فلا بد من تقدّمٍ حاسمٍ على مستوى الأفكار. لقد دخلنا الثورة بنيّات طيبة وأفكار مشتتة، وخسرنا جزئياً لذلك.
أي سورية؟
عمِلتْ هذه المناقشة على بيان منطق المفارقة المتمثلة في أن أكبر ثوراتنا الديمقراطية أدخلت المجموعات الديمقراطية في أزمة عميقة، وحاولت توفير عناصر تحليلية للتفكير في أزمة وطنيةٍ ومواطنة، تُشكل أزمةُ الديمقراطيين أحد أوجهها. تنظر هذه المناقشة إلى الوراء، إلى السنوات الفظيعة الماضية، لكنها موجهة نحو المستقبل: أن نتعلم من التجربة وأن يؤسِّس هذا التعلُّم لذاتيات جديدة، أقل إعاقة وأكثر حرية.
هناك في النهاية سؤال عملي شاق يواجهنا اليوم، يتصل بالتوتر بين وحدة سورية أسدياً أو دوام الانقسام الحالي. الجواب الشخصي لكاتب هذه السطور هو عدم عودة الحكم الأسدي ولو بثمن الانقسام ودوامه. ومعيارُ التقرير في هذا الشأن من وجهة نظر ديمقراطية هو الجماعات المحلية، التي يبدو أن أكثريات مهمة منها لا تريد عودة دولة البراميل والكيماوي والتعذيب والاغتصاب.
فإذا انطوت صفحة هذه الدولة، فربما يفضل المرء بلداً له سلفاً تاريخ يزيد على قرن، وله سلفاً قصة كفاح رهيبة ضد حكم الطغيان: سورية الموحدة. واستناداً إلى كتاب ممداني المذكور فوق فسنكون ناجين كلنا، بمن فينا الموالون للنظام، فقط حين يسقط حكم التمييز والإبادة، ونسير نحو جماعة مواطنين سورية، لا تُعرف بقومية أو دين أو طائفة. لا أحد ناجٍ ما استمر الحكم الأسدي. الكل ضحايا.


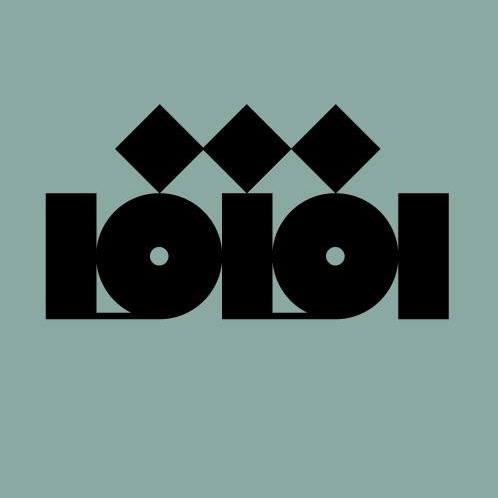




أضف تعليق